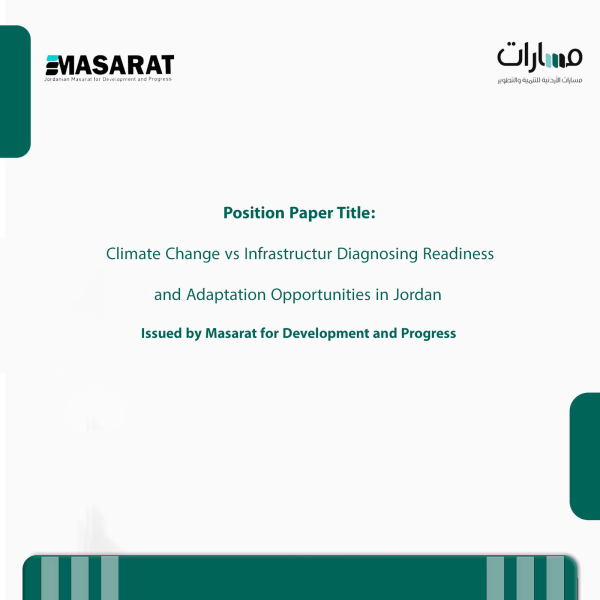ورقة موقف بعنوان: الشرق الأوسط مسرح لتصفية الحسابات... من يدفع الثمن؟ صادرة عن مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير

المقدمة:
تنبثق هذه الورقة من قلب النقاش المحتدم حول طبيعة الصراعات في الشرق الأوسط، ذلك أن تضاريسه الجيوسياسية المعقدة، وثرائه بالموارد، وموقعه الاستراتيجي الفريد، أصبح بمثابة مسرح عالمي لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى، بينما تتحمل الشعوب عبء هذه المعارك المعقدة على نحو غير أخلاقي.
إن هذه الورقة تتناول، من منظور تحليلي عميق آثار مباشرة وغير مباشرة على المجتمعات العربية: من فقدان الأمن الغذائي والاقتصادي إلى تفكك البنى الاجتماعية واستنزاف الكفاءات البشرية.
في جوهرها، تتناول الورقة سؤالًا محوريًا: من يدفع الثمن؟.
الفصل الأول: ما يحتاجه الشرق الأوسط حتى يقرأ خصمه
إن المنطقة، في بنيتها الراهنة، تعيش حالة انتقال غير مكتملة بين نظام إقليمي قديم فقد تماسكه، ونظام جديد لم تتبلور ملامحه بعد، الأمر الذي يخلق حالة سيولة استراتيجية تسمح بتصاعد النزاعات، وتوسّع هوامش التدخل الخارجي، وتنامي أدوار الفاعلين غير الدوليين، في مقابل تراجع نسبي لقدرة بعض الدول على احتكار أدوات السيادة والضبط الداخلي.
وفي هذا السياق، تتجلى مظاهر عدم الاستقرار بوضوح في عدد من الدول المركزية في الإقليم، حيث لا تزال سوريا، والعراق، ولبنان، وفلسطين تعاني من أزمات مركبة، تتوزع بين ضعف المؤسسات، والانقسام السياسي، والضغوط الاقتصادية، وتداعيات النزاعات المسلحة، وهو ما يجعلها بؤرًا مفتوحة لإعادة إنتاج التوترات الإقليمية والدولية.
ضمن هذا المشهد، يتأثر الأردن بصورة مباشرة وعميقة بهذه التحولات، بحكم موقعه الجغرافي، وتشابك مصالحه الاقتصادية، وارتباط أمنه الوطني بالاستقرار الإقليمي. ويتجلى هذا التأثر في ثلاثة مستويات متداخلة:
أولًا: المستوى السياسي - الأمني، المرتبط بملفات الحدود، واللاجئين، والتوازنات الإقليمية، ومسارات التسوية في القضايا الكبرى وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
ثانيًا: المستوى الاقتصادي، المتصل بحركة التجارة، وأسواق الطاقة، وفرص إعادة الإعمار في الدول المجاورة، والضغوط المرتبطة بالإنفاق العام والتحديات المالية.
ثالثًا: المستوى الاجتماعي، حيث تنعكس الأزمات الإقليمية على المزاج العام، وتوقعات المجتمع، وإدراكه لمستقبل الاستقرار في المنطقة.
ومن جهة أخرى، يُعاد طرح مفهوم "الشرق الأوسط الجديد" بوصفه إطارًا تفسيريًا لمحاولات إعادة تشكيل موازين القوى في الإقليم، سواء عبر إعادة ترتيب التحالفات، أو عبر فرض ترتيبات أمنية واقتصادية جديدة، أو من خلال الدفع باتجاه نماذج حكم مختلفة في بعض الدول. غير أن هذا الطرح لا ينفصل عن سياق أوسع يتعلّق بإعادة هيكلة النظام الدولي ذاته، في ظل صعود قوى دولية منافسة، وتراجع نسبي في قدرة القوة المهيمنة على فرض نماذجها دون مقاومة أو كلفة.
وفي قلب هذه المعادلات، يبرز الملف السوري بوصفه حالة مفصلية ذات امتدادات سياسية، وأمنية، واقتصادية واسعة، نظرًا لارتباطه المباشر بملفات إعادة الإعمار، وحركة اللاجئين، وتوازنات القوى الإقليمية، فضلًا عن موقعه في الحسابات الدولية المرتبطة بممرات الطاقة والنفوذ الجيوسياسي. كما يشكّل هذا الملف بالنسبة للأردن عمقًا استراتيجيًا ذا أبعاد متعددة، تتجاوز البعد الحدودي إلى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستقرار الإقليمي.
في المقابل، تظل القضية الفلسطينية العامل الأكثر ثباتًا وتأثيرًا في معادلات الشرق الأوسط، بوصفها قضية مركزية تعيد تشكيل الاصطفافات السياسية، وتؤثر في مستويات التوتر الإقليمي، وتستحضر باستمرار تفاعلات دولية معقّدة. كما أنها تمثل أحد أهم محددات الموقف الأردني الخارجي، بالنظر إلى ارتباطها التاريخي والسياسي والأمني بالمملكة، وبحكم انعكاساتها المباشرة على الاستقرار الداخلي والإقليمي.
أما على المستوى الدولي، فإن الشرق الأوسط ما يزال يمثل إحدى أهم ساحات التنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى، حيث تتقاطع فيه استراتيجيات الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والاتحاد الأوروبي، في ملفات متعددة تشمل أمن الطاقة، والممرات البحرية، والتحالفات العسكرية، والأسواق، والنفوذ السياسي. ويتخذ هذا التنافس أشكالًا غير مباشرة في كثير من الأحيان، عبر الحروب بالوكالة، أو الضغوط الاقتصادية، أو إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية.
وفي هذا الإطار، يمكن رصد مجموعة من المحددات التي تحكم ديناميات الصراع في المنطقة، من أبرزها:
- التنافس على مصادر الطاقة وخطوط الإمداد وممرات التجارة العالمية.
- الصراع على النفوذ الجيوسياسي وإعادة رسم مناطق التأثير.
- تصاعد دور الفاعلين من غير الدول، وما ينتجه ذلك من تعقيد في بنية الصراع.
- تزايد الاعتماد على الأدوات الاقتصادية والتكنولوجية كوسائل للنفوذ والسيطرة.
وتتجاوز آثار هذه المحددات المجال السياسي إلى المجال المجتمعي، حيث تتجلّى في موجات اللجوء والنزوح، وتراجع مستويات التنمية، واتساع الفجوات الاجتماعية، وتزايد الضغوط النفسية والاقتصادية على المجتمعات المحلية. كما تمتد تداعياتها إلى النظام الدولي ذاته، في ظل تنامي الجدل حول فاعلية المؤسسات الدولية، وحدود القانون الدولي، وإشكاليات تطبيق معايير حقوق الإنسان في سياقات النزاعات الممتدة.
بناءً على ما تقدم، يمكن القول إن الشرق الأوسط يقف عند مفترق تاريخي تتداخل فيه مسارات إعادة تشكّل النظام الإقليمي مع تحولات أوسع في بنية النظام الدولي، الأمر الذي يضع دول المنطقة، ومنها الأردن، أمام تحدي صياغة مقاربات استراتيجية قادرة على التكيّف مع بيئة شديدة السيولة والتعقيد، دون الوقوع في فخ الارتهان الكامل لتوازنات القوى الخارجية.
الفصل الثاني: إحكام القبضة على موارد الشرق الأوسط
ينتقل التحليل في هذا الفصل من توصيف السياق العام للإقليم إلى تفكيك موازين القوة الفعلية التي تحكم حركته، بوصفها موازين لا تُدار وفق منطق الانتصارات الصافية أو الهزائم المطلقة، بقدر ما تُدار ضمن مقاربات براغماتية تضع تقليل الخسائر وتعظيم المكاسب الجزئية في صلب التفكير الاستراتيجي للدول.
في هذا الإطار، لا يمكن فهم ديناميات الشرق الأوسط بمعزل عن إدراك طبيعة الهرمية الدولية القائمة، حيث تستمر الولايات المتحدة في احتلال موقع القوة الأكثر تأثيرًا في النظام الدولي، ليس فقط بفضل تفوقها العسكري، وإنما أيضًا عبر أدوات الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية والمؤسسية، وقدرتها على إعادة إنتاج نفوذها من خلال التحالفات والشبكات العابرة للدول. وضمن هذا الواقع، تتجه القوى الإقليمية الفاعلة إلى مقاربة تقوم على إدارة العلاقة مع هذه القوة، لا على مواجهتها المباشرة، انطلاقًا من حسابات الكلفة والمخاطر وحدود القدرة الذاتية.
تبرز في هذا السياق مجموعة من القوى الإقليمية التي تمثل ما يمكن تسميته "كتلة الوزن النسبي الاستراتيجي" في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها تركيا، وإيران، والسعودية، ومصر، بوصفها دولًا تمتلك عناصر مركّبة من القوة، تشمل القدرات العسكرية، والموارد الاقتصادية، والموقع الجيوسياسي، والتأثير السياسي في محيطها. غير أن هذه القوى، رغم تباين مواقعها وتحالفاتها، لا تتحرك ضمن منطق الصدام الشامل مع القوة المهيمنة دوليًا، بل ضمن منطق التفاوض المستمر معها، والسعي إلى إنتاج تفاهمات مرحلية تحافظ على مصالحها وتحدّ من الخسائر المحتملة.
هذا المنطق يعكس تحوّلًا في التفكير الاستراتيجي داخل الإقليم، حيث لم تعد فكرة "الانتصار الكامل" مطروحة واقعيًا في ظل اختلال موازين القوة، إذ باتت الأولوية تُمنح لسياسات إدارة الأزمات، وتفادي الانهيارات، والخروج من الصراعات بأقل قدر ممكن من الخسائر السياسية والاقتصادية والأمنية. وهي مقاربة تستند إلى ما يُعرف في الأدبيات السياسية بمفهوم "الواقعية البراغماتية"، التي تُعلي من شأن التكيف مع موازين القوة بدلًا من تحدّيها دون امتلاك أدوات موازنة حقيقية.
ومن زاوية أخرى، يتضح أن الصراعات في الشرق الأوسط أصبحت تُدار في معظمها من خلال نمط متصاعد من الحروب بالوكالة، حيث يجري توظيف الفاعلين الإقليميين والمحليين لتنفيذ أهداف استراتيجية ضمن أطر صراع غير مباشر. وتتيح هذه الصيغة للقوى الكبرى تحقيق مكاسب جيوسياسية واقتصادية دون الانخراط في كلفة المواجهة العسكرية المباشرة، مع إبقاء الإقليم في حالة استنزاف مستمر.
كما يرتبط هذا النمط بإعادة تعريف مفهوم السيطرة في الشرق الأوسط، إذ بات يشمل أشكالًا متعددة من النفوذ، مثل:
- السيطرة الأمنية عبر ترتيبات إقليمية وتحالفات عسكرية.
- التأثير الاقتصادي من خلال أدوات التمويل والاستثمار والعقوبات.
- إعادة تشكيل البنى الديموغرافية عبر النزوح والتهجير.
- الهيمنة التكنولوجية والمعلوماتية، وتأثيرها في الرأي العام وصنع القرار.
وفي هذا السياق، تتشكل في المنطقة مشاريع نفوذ متوازية ومتنافسة، تتداخل فيها الاستراتيجيات الأمريكية، والإسرائيلية، والتركية، والإيرانية، إلى جانب محاولات عربية لإعادة بناء أطر تعاون إقليمي قادرة على موازنة الضغوط الخارجية. غير أن هذه المشاريع لا تعمل بمعزل عن بعضها، فهي تتقاطع في كثير من الأحيان ضمن ترتيبات تفاوضية أو صراعية مؤقتة، وفقًا لمعادلات المصالح والتهديدات.
أما على المستوى العسكري، فقد شهدت الاستراتيجية الأمريكية تحوّلًا واضحًا من نمط التدخل المباشر واسع النطاق إلى نمط "الانخراط غير المباشر"، الذي يعتمد على الحلفاء الإقليميين، والأدوات الاستخبارية، والضغط الاقتصادي، والعمليات المحدودة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية دون الانزلاق إلى حروب طويلة مكلفة. وتُفهم في هذا الإطار العديد من النزاعات في المنطقة بوصفها حلقات ضمن صراعات أوسع تُدار على مدى زمني طويل، حيث تتراكم الضغوط السياسية والاقتصادية قبل الوصول إلى المواجهة العسكرية المحدودة أو الضربة الحاسمة.
ومن منظور تحليلي أعمق، يمكن القول إن الصراع في الشرق الأوسط أصبح صراعًا على إعادة تشكيل البنى السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية للدول، وعلى إعادة توزيع مراكز النفوذ داخل الإقليم. ويتجلى ذلك في محاولات إعادة تعريف مفهوم "الشرق الأوسط" ذاته، سواء من حيث حدوده السياسية، أو مكوناته الديموغرافية، أو ترتيباته الأمنية، أو أنماطه الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، تبرز إشكالية جوهرية تتعلق بقدرة الدول العربية على صياغة مشروع إقليمي ذاتي قادر على تقليل الاعتماد على القوى الخارجية، وتعزيز القدرة التفاوضية الجماعية. إذ تشير التجارب السابقة إلى أن غياب التنسيق الاستراتيجي العربي، وتباين الأولويات الوطنية، وتراكم الأزمات الداخلية، قد أسهم في إضعاف القدرة على إنتاج مواقف موحدة أو مبادرات إقليمية مستقلة.
ومع ذلك، فإن التحولات الجارية في بنية التحالفات الإقليمية، والتقارب في بعض الملفات الاقتصادية والأمنية، قد تفتح المجال أمام نشوء صيغ تعاون جديدة، وإن بقيت محكومة بحدود الواقعية السياسية ومقتضيات التوازن الدولي.
بناءً على ما سبق، يمكن القول إن الشرق الأوسط يتجه خلال السنوات المقبلة نحو مرحلة تتسم بإدارة الصراع أكثر من حسمه، وبمحاولات دائمة لإعادة ضبط موازين القوى دون الوصول إلى نقطة استقرار نهائي. وفي ظل هذه المعادلة، يصبح الهدف الواقعي للفاعلين الإقليميين ليس تحقيق انتصارات حاسمة، بقدر ما يتمثل في تحسين شروط التفاوض، وتقليل كلفة الصراع، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ويمهّد هذا الفصل للانتقال إلى تحليل أكثر تخصّصًا في الفصول اللاحقة، يتناول المشاريع الإقليمية المتنافسة، وأنماط التحالفات، وتأثيرها المباشر على الدول المتأثرة بالتفاعلات الإقليمية، وعلى رأسها الأردن، من حيث الخيارات الاستراتيجية المتاحة، وحدود الحركة، وفرص التكيّف مع بيئة إقليمية شديدة التقلب.
الفصل الثالث: كلفة الانخراط في دور البطل
تاريخيًا، شكّلت المنطقة مسرحًا لتفاعل مشاريع قومية وإقليمية متباينة، غير أن المرحلة الراهنة تكشف عن انتقال هذه المشاريع من منطق الصدام الأيديولوجي المباشر إلى منطق النفوذ المركّب، الذي يعتمد على أدوات متعددة تشمل الاقتصاد، والطاقة، والأمن، والديموغرافيا، والتكنولوجيا، وإدارة الأزمات الداخلية للدول.
ضمن هذا السياق، يبرز مثلث إقليمي فاعل في صياغة مسارات الشرق الأوسط، يتمثل في إسرائيل، وإيران، وتركيا، إلى جانب أدوار عربية متغيرة، في مقدمتها السعودية، ومصر. هذا التشكيل لا يعكس تحالفًا ثابتًا بقدر ما يعكس بنية تنافس معقّدة، تتقاطع فيها المصالح وتتنافر في آنٍ واحد، وفقًا لمعادلات اللحظة السياسية وتوازنات القوى الدولية.
كما يبرز في هذا المشهد مفهوم "الدور الوظيفي للدول"، بوصفه مفهومًا تحليليًا يفسّر طبيعة انخراط الدول في النظام الدولي، حيث تؤدي كل دولة – بدرجات متفاوتة – وظائف محددة ضمن شبكة المصالح العالمية، سواء في مجالات الأمن، أو الطاقة، أو التجارة، أو التوازنات السياسية. ولا يُعد هذا الدور، في ذاته، مؤشرًا على الضعف أو التبعية، ذلك أنه يرتبط بقدرة الدولة على توظيف موقعها الجيوسياسي لتعظيم مكاسبها وتقليل كلف انخراطها في الصراعات.
أما على مستوى القوى الدولية، فيُلاحظ استمرار الحضور الأمريكي بوصفه العامل الأكثر تأثيرًا في تفاعلات الشرق الأوسط، سواء من خلال التحالفات العسكرية، أو النفوذ الاقتصادي، أو القدرة على إدارة مسارات الصراع. وفي المقابل، لا تزال أدوار روسيا والصين محكومة باعتبارات مختلفة؛ إذ يتركز الاهتمام الروسي في مساحات جيوسياسية قريبة من حدوده الحيوية، بينما تعتمد الصين مقاربة تقوم على التمدد الاقتصادي والتجاري دون انخراط عسكري مباشر واسع النطاق، ما يجعل تأثيرهما في الإقليم مختلفًا في طبيعته عن التأثير الأمريكي.
كما أن التحولات داخل دول الخليج، والتقارب في بعض الملفات الإقليمية، ومحاولات إعادة تعريف أدوار الدول العربية الكبرى، تشير إلى مسار تدريجي لإعادة صياغة موقع المنطقة داخل النظام الدولي، بحيث تنتقل من موقع "ساحة الصراع" إلى موقع "فاعل تفاوضي" يسعى إلى حماية مصالحه ضمن بيئة دولية معقدة.
من ناحية أخرى، تتداخل في الإقليم صراعات الهوية والطائفة والقومية مع الصراعات الجيوسياسية، ما يزيد من تعقيد المشهد ويُضعف القدرة على إنتاج مشاريع جامعة عابرة للانقسامات. وقد أسهمت هذه التداخلات في إطالة أمد الأزمات، وتحويلها إلى صراعات ممتدة يصعب حسمها عسكريًا أو سياسيًا في المدى القصير.
الفصل الرابع: دور الضحية وأعباءه
يقود التراكم المركّب للتحولات الإقليمية، وتداخل مشاريع النفوذ الدولية، واستمرار بؤر الصراع المفتوحة، إلى نتيجة مركزية تتمثل في تعمّق حالة ضعف الإقليم العربي، بوصفها نتاجًا تاريخيًا لتفاعلات سياسية وأمنية واقتصادية ممتدة، تضافرت فيها العوامل الخارجية مع الانقسامات الداخلية لتنتج بيئة هشّة قابلة للاختراق والتفكك.
وفي هذا السياق، تتجه القراءة التحليلية إلى اعتبار أن الكلفة الفعلية للصراعات الدائرة في المنطقة لم تتحملها القوى الكبرى أو الفاعلون الدوليون بقدر ما تحملتها الدول والمجتمعات العربية، سواء من حيث تآكل الدولة الوطنية، أو تفكك النسيج الاجتماعي، أو اتساع مساحات الهشاشة السياسية، والاقتصادية، والأمنية. فقد تحوّلت مجتمعات بأكملها إلى مسارح استنزاف مفتوحة، تتقاطع فيها الصراعات الهوياتية والطائفية مع الضغوط الجيوسياسية، في ظل ضعف القدرة المؤسسية على إدارة الأزمات أو احتوائها.
ولا يمكن فهم هذا المسار بمعزل عن الطبيعة البراغماتية للسياسات الدولية والإقليمية، حيث تتحرك القوى الفاعلة وفق منطق المصلحة الاستراتيجية أكثر من أي اعتبارات معيارية أو أخلاقية. فالعلاقات الدولية، في بنيتها الواقعية، تُدار ضمن منظومات القوة وتوازناتها، الأمر الذي يجعل من المنطقة مجالًا لتقاطع المصالح وتنافسها، لا سيما في ظل أهميتها الجيوسياسية وارتباطها بملفات الطاقة والأمن والممرات الحيوية.
وفي خضم هذا المشهد، برزت الصراعات الهوياتية بوصفها أحد أكثر العوامل تفتيتًا للمنطقة، إذ أسهمت الانقسامات الأيديولوجية والطائفية في إعادة تشكيل خطوط التوتر داخل الدول، وفي إضعاف قدرتها على إنتاج توافقات داخلية جامعة. وقد أفضى ذلك إلى تعميق الانقسامات المجتمعية، وتحويلها في بعض الحالات إلى صراعات مفتوحة ذات امتدادات إقليمية، ما أدى إلى استدامة الأزمات بدل احتوائها.
وتتضاعف خطورة هذه التحولات حين تتقاطع مع مركزية القضية الفلسطينية في الوعي العربي، بوصفها قضية سياسية وإنسانية مفصلية. إذ يشير عدد من التحليلات إلى أن القضية، على الرغم من استمرار حضورها الرمزي والسياسي، تعرّضت في بعض المراحل إلى توظيف إقليمي ودولي ضمن حسابات النفوذ والصراع، بما أدى إلى إزاحتها جزئيًا من موقعها كقضية تحرر وطني جامعة، إلى موقع ورقة ضغط تُستدعى في سياقات التنافس السياسي والإقليمي.
وعلى مستوى الخسائر الاستراتيجية، يمكن تمييز ثلاث دوائر رئيسية للتأثر:
أولًا: الدائرة الفلسطينية، بوصفها الأكثر تعرضًا للضغط المباشر، سواء على مستوى الواقع الميداني أو على مستوى التمثيل السياسي ووحدة القرار الوطني.
ثانيًا: دائرة دول الجوار الإقليمي، التي وجدت نفسها في قلب تداعيات الصراع، أمنيًا واقتصاديًا وديموغرافيًا، بحكم الموقع الجيوسياسي والتداخل البنيوي مع القضية الفلسطينية وتفاعلاتها.
ثالثًا: الدائرة العربية الأوسع، التي انعكست عليها التحولات في صورة تراجع في فاعلية النظام الإقليمي العربي، واتساع الفجوة بين الإمكانات الجماعية والقدرة الفعلية على التأثير.
وفي الحالة الأردنية على وجه الخصوص، يكتسب موقع الدولة حساسية مضاعفة بحكم تموضعها في قلب التفاعلات الإقليمية، ما يجعلها عرضة لتأثيرات مباشرة وغير مباشرة ناجمة عن اختلال التوازنات المحيطة. غير أن هذه الحساسية لا تعني غياب القدرة على المناورة أو التحصين، بقدر ما تضع الوعي الوطني وتماسك الجبهة الداخلية في صدارة محددات الاستقرار.
التجارب الإقليمية خلال العقدين الماضيين تشير إلى أن الانقسامات الأيديولوجية الحادة شكّلت أحد أبرز مداخل إضعاف الدول، حين تحوّلت الخلافات الفكرية والسياسية إلى صراعات بنيوية تهدد كيان الدولة ذاته. ومن هنا، تتقدم فكرة "الإجماع الوطني" بوصفها أداة وقائية، تهدف إدارة الاختلاف ضمن سقف الدولة ومؤسساتها.
وفي المقابل، يبرز تحدٍ آخر يتمثل في ميل الخطاب العام، في بعض الحالات، إلى ترسيخ صورة الذات بوصفها "ضحية دائمة" للصراعات الدولية، دون الانتقال إلى مقاربة تستند إلى شروط الفاعلية السياسية والاستراتيجية. إذ إن الانتقال من موقع التلقي إلى موقع المبادرة يتطلب إعادة تعريف الأولويات، وبناء سياسات قائمة على فهم الإمكانات الذاتية وحدودها، بدل الانخراط في رهانات تتجاوز القدرة الواقعية للدولة.
ويكتسب هذا البعد أهمية خاصة في ظل بيئة إقليمية لا تتسامح مع الأخطاء الاستراتيجية، حيث يمكن لأي انزلاق سياسي أو أمني أن يُنتج كلفًا مرتفعة تتجاوز حدود الدولة المعنية إلى نطاقات أوسع. ومن ثم، يصبح ضبط التوقعات، وربط الخطاب السياسي بالإمكانات الواقعية، عنصرًا حاسمًا في تجنب الانجرار إلى مسارات عالية المخاطر.
وفي السياق ذاته، يفرض تطور النظام الدولي – واتجاهه نحو تعددية قطبية نسبية – على الدول الصغيرة والمتوسطة تبني استراتيجيات بقاء مرنة، تقوم على تنويع العلاقات، وإدارة التوازنات، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجيوسياسي دون الارتهان الكامل لأي محور.
أما على المستوى المعرفي، فتشير تجارب عدة إلى أن ضعف الاستثمار في مراكز التفكير وصناعة القرار الاستراتيجي أسهم في تقليص القدرة على استشراف التحولات والتعامل معها بفاعلية. فصناعة السياسات لا تقوم على ردود الفعل الآنية بقدر ما تستند إلى تراكم معرفي وتحليل استراتيجي طويل المدى، يربط الماضي بالحاضر ويستشرف المستقبل.
وبناءً على ذلك، يمكن القول إن ما تعيشه المنطقة يعد طورًا تاريخيًا تتداخل فيه إعادة تشكيل موازين القوى مع إعادة تعريف دور الدولة الوطنية ووظائفها. وفي ظل هذا الطور، تتحدد فرص البقاء والتأثير بمدى قدرة الدول على ترميم الداخل، وإدارة الاختلاف، وتحصين المجال الوطني، والانخراط في الإقليم والعالم من موقع الفاعل لا المفعول به.
الفصل الخامس: استحضار التاريخ... التباهي مقابل التباكي
يفضي تحليل مسار التفاعلات الدولية والإقليمية إلى ضرورة الانتقال من المقاربة الانفعالية للصراع إلى مقاربة معرفية استراتيجية تقوم على فهم أنماط تفكير القوى الكبرى، وآليات اشتغالها، وحدود تحركها. فإدراك طبيعة السلوك الدولي لا يتحقق عبر تتبع الأحداث بوصفها فضائح سياسية أو وقائع معزولة، وإنما من خلال تحويلها إلى مادة تحليلية تُبنى عليها سياسات واقعية، قادرة على التكيّف مع موازين القوة القائمة.
وفي هذا السياق، يتبدّى أن أحد أوجه الخلل في المقاربات العربية تمثّل في الميل إلى استدعاء التاريخ إما بوصفه مساحة للتباهي أو للتباكي، دون تحويله إلى أداة معرفية لاستشراف المستقبل. إذ إن قراءة الماضي بوصفه خبرة تراكمية، لا سردية عاطفية، تتيح إعادة فهم أنماط التدخل الخارجي، ومسارات إنتاج الانقسام، وآليات إعادة تشكيل الهوية السياسية في المنطقة.
وقد أسهمت التوترات الهوياتية، عبر الزمن، في تكريس أنماط من التصنيف والانقسام داخل المجتمعات، ما أضعف القدرة على إنتاج مشروع سياسي جامع. وفي هذا الإطار، يصبح استحضار التاريخ أداة لإعادة بناء الوعي، لا لإعادة إنتاج الانقسام، بما يسمح بفهم كيف تشكّلت البنى السياسية والاجتماعية الراهنة، وكيف يمكن تفكيك أسباب هشاشتها.
ومن زاوية أخرى، يفرض تحليل التفاعلات الدولية الاعتراف بأن المنطقة محكومة، بدرجة كبيرة، بمنطق القوة وتوازناتها. فالدور الدولي في الشرق الأوسط تأسس عبر إدراك استراتيجي لأهمية الجغرافيا السياسية، والموارد، وممرات الطاقة، والتموضع الأمني. ومن ثمّ، فإن الدول التي لا تستوعب قواعد الاشتباك في هذا النظام الدولي تجد نفسها في موقع الخاسر.
وفي ضوء ذلك، يتضح أن إعادة قراءة التجربة السياسية العربية، بما فيها التجربة الفلسطينية، تكشف عن مركزية عامل الوحدة الداخلية في تعزيز القدرة التفاوضية والسياسية. إذ تشير خبرات تاريخية متعددة إلى أن الانقسام الداخلي غالبًا ما كان مدخلًا لتآكل القدرة على الفعل السياسي، وإضعاف الموقع التفاوضي في مواجهة الضغوط الخارجية.
كما أن التحولات التي شهدها النظام الدولي منذ نهاية الحرب الباردة أفرزت بيئة أحادية أو شبه أحادية القطبية لفترة زمنية، قبل أن تتجه تدريجيًا نحو تعددية نسبية في مراكز القوة. غير أن هذا التحول لا يعني تراجعًا حاسمًا للقوة المهيمنة بقدر ما يعكس إعادة توزيع لأدوات النفوذ بين العسكري والاقتصادي والتكنولوجي.
وفي السياق ذاته، تبرز مسألة "المشروع السياسي" بوصفها الحلقة الأضعف في التجربة العربية المعاصرة، حيث لم تتبلور رؤية إقليمية متماسكة قادرة على توحيد الموارد والإمكانات ضمن إطار استراتيجي طويل المدى. وقد أدى ذلك إلى بقاء الدول في موقع ردّ الفعل، بدل الانتقال إلى موقع المبادرة.
وعلى المستوى المقارن، تُظهر تجارب دولية عدة أن التعامل مع القوى الكبرى لا يرتبط فقط بحجم القوة العسكرية، فالدول التي استطاعت الحفاظ على استقرارها لم تفعل ذلك عبر المواجهة المباشرة، وإنما عبر مزيج من البراغماتية السياسية، والمرونة الدبلوماسية، وتعظيم المصالح الوطنية.
وفي الحالة الأردنية، يبرز هذا المنطق بوصفه ضرورة وجودية، لا خيارًا سياسيًا فقط. فالموقع الجغرافي، وتشابك الملفات الإقليمية، وحساسية التوازنات الداخلية، كلها عوامل تجعل من إدارة السياسة الخارجية عملية دقيقة تتطلب حسابات متعددة المستويات، وتوازنًا بين الثوابت الوطنية ومتطلبات الواقع الدولي.
كما أن تحصين الجبهة الداخلية يظل العامل الأكثر تأثيرًا في قدرة الدولة على المناورة الخارجية. فالتماسك المجتمعي، والوعي الوطني، ووضوح الأولويات، تمثل خطوط الدفاع الأولى في مواجهة الضغوط، وتمنح صانع القرار هامشًا أوسع للحركة في بيئة إقليمية معقدة.
ومن زاوية أخرى، فإن التفكير الاستراتيجي يقتضي تجاوز منطق الاعتماد على "المنقذ الخارجي"، أو الرهان على تحولات دولية مفاجئة، لصالح بناء قدرات ذاتية تدريجية، قائمة على فهم الإمكانات الوطنية، واستثمار الموقع الجيوسياسي، وتطوير أدوات التأثير الاقتصادي والسياسي.
وبناءً على ما تقدم، يمكن القول إن التحدي الحقيقي أمام الدول العربية يكمن في القدرة على تحويل المعرفة إلى سياسات، والتاريخ إلى دروس، والانقسام إلى توافق، والضعف إلى مشروع إصلاحي طويل المدى.
الفصل السادس: فرص المناورة... حدود التماسك... وتجاوز الخلافات
ينطلق هذا الفصل من فرضية مركزية مفادها أن قدرة الدولة على المناورة في بيئة إقليمية مضطربة تتحدد بمدى تماسكها الداخلي، ووضوح مشروعها الوطني، وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص. فالقوة الوطنية، في سياق الدول متوسطة الموارد، تقاس بقدرة المجتمع والدولة على إنتاج توافقات داخلية، وإدارة الخلافات ضمن أطر مؤسسية، وبناء اقتصاد قادر على الصمود.
أولًا: الجبهة الداخلية بين التماسك والاختلاف المشروع
يُظهر الواقع الأردني وجود قدر معتبر من التوافق حول الثوابت الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها استقرار الدولة، والحفاظ على هويتها السياسية، وحماية مصالحها الاستراتيجية. غير أن هذا التوافق لا ينفي وجود اختلافات في الرؤى والخيارات بين مكونات المشهد السياسي والاجتماعي، وهو أمر طبيعي في المجتمعات الحديثة، لكنه يصبح عامل إضعاف عندما يتحول إلى قطيعة سياسية أو انقطاع في قنوات الحوار.
إن غياب الحوار المنظم بين الدولة والقوى السياسية والمجتمعية يفضي، تدريجيًا، إلى تصلّب المواقف، وتضييق مساحات التفاهم، وتعزيز النزعات الدفاعية داخل كل طرف. وفي المقابل، يتيح الحوار المؤسسي إعادة بناء الثقة، وتوسيع دائرة المشاركة، وتخفيف الاحتقان، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة التحديات الخارجية من موقع داخلي أكثر تماسكًا.
ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى إعادة تفعيل منصات الحوار الوطني بوصفها أداة استراتيجية، لا مجرد إجراء سياسي مرحلي، بحيث تُبنى حولها مقاربات مشتركة تتعلق بمستقبل الدولة، وأولوياتها الاقتصادية، وحدود خياراتها الإقليمية.
ثانيًا: الاقتصاد بوصفه عامل استقرار أو عامل تفجير
تؤكد الخبرات المقارنة أن الضغوط الاقتصادية تمثل أحد أكثر العوامل تأثيرًا في استقرار الدول، خصوصًا عندما تتقاطع مع اختلالات اجتماعية أو شعور متزايد بعدم العدالة. وفي الحالة الأردنية، يبرز الاقتصاد بوصفه أحد أهم محددات الاستقرار الداخلي، بوصفه عاملًا مباشرًا في صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع.
فالاستمرار في أنماط النمو المحدودة، وارتفاع كلف المعيشة، والبطالة، وتراجع القدرة الشرائية، كلها عوامل قد تتحول إلى مصادر ضغط داخلي إذا لم تُعالج ضمن رؤية اقتصادية طويلة المدى. وفي المقابل، يمكن للاقتصاد أن يتحول إلى رافعة استقرار عبر توسيع الإنتاج، وتحفيز الاستثمار، وتطوير القطاعات الحيوية.
وفي هذا السياق، تبرز فكرة إعادة احتساب الكلفة التي تحملتها الدولة نتيجة أدوارها الإقليمية، خاصة فيما يتعلق باستضافة اللاجئين وتقديم الخدمات الإنسانية. فهذه الأدوار، رغم طابعها الأخلاقي والإنساني، خلّفت أعباءً كبيرة على البنية التحتية والاقتصاد الوطني، ما يستدعي تطوير آليات دولية أكثر استدامة لتقاسم الكلفة، وتحويل الدعم من طابع إغاثي مؤقت إلى شراكات تنموية طويلة الأمد.
ثالثًا: تنويع الشراكات وتقليل الاعتماد الأحادي
تفرض التحولات الدولية على الدول متوسطة الحجم تبني سياسات خارجية مرنة، تقوم على تنويع الشراكات بدل الارتهان لمحور واحد. فالتعدد في العلاقات السياسية والاقتصادية يوسّع هامش الحركة، ويقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات السياسة الدولية.
ويشمل ذلك تعزيز التعاون مع الدول العربية، وتطوير العلاقات مع أوروبا، والانفتاح على قوى اقتصادية صاعدة، مع الحفاظ على التوازن في العلاقات مع القوى الكبرى. ولا يعني ذلك القطيعة مع الشركاء التقليديين، وإنما إعادة صياغة العلاقة على أساس المصالح المتبادلة، والاحترام المتبادل للسيادة والخصوصية الوطنية.
رابعًا: تقليص الاعتماد على الإقليم الملتهب وبناء الاكتفاء النسبي
إن الموقع الجغرافي للأردن يفرض عليه التفاعل مع محيط مضطرب، غير أن هذا التفاعل لا ينبغي أن يتحول إلى اعتماد اقتصادي مفرط على بيئات غير مستقرة. ومن هنا، تبرز أهمية تطوير سياسات تقلل من الانكشاف على الأزمات الإقليمية، عبر تعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.
ويشمل ذلك:
- الاستثمار في الطاقة المتجددة، بما يخفف الاعتماد على الاستيراد ويعزز الاستقلالية الطاقية.
- تطوير مشاريع الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على سلاسل توريد خارجية متقلبة.
- استثمار الموارد الطبيعية المتاحة ضمن أطر شفافة ومستدامة.
- تحفيز القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل حقيقية.
خامسًا: الدبلوماسية النشطة بوصفها خط دفاع أول
يشكل الحضور الدبلوماسي الفاعل أداة رئيسة في حماية المصالح الوطنية، خاصة في بيئة إقليمية تتكثف فيها الصراعات. فإيصال رواية الدولة، وتوضيح أهمية استقرارها، وتثبيت دورها الإقليمي، عناصر تسهم في تعزيز مكانتها، وتدعم قدرتها على استقطاب الدعم السياسي والاقتصادي.
وفي هذا الإطار، لا تنفصل الدبلوماسية عن الداخل؛ إذ إن قوة الخطاب الخارجي ترتبط بصلابة الجبهة الداخلية، وبوضوح المشروع الوطني الذي تتحدث باسمه الدولة.
سادسًا: الإنسان بوصفه محور الأمن الوطني
تظهر التحولات المعاصرة أن الصراعات لم تعد تقتصر على المجال العسكري، فقد امتدت إلى الفضاء الرقمي، والاقتصادي، والثقافي، والمعرفي. وتزداد أهمية العنصر البشري في هذا السياق، بوصفه محور الصمود والتعافي.
فالاستثمار في التعليم، وتطوير المناهج، وتمكين الشباب، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، كلها عناصر تشكل خطوط الدفاع العميقة للدولة. كما أن تجاهل هذه الجوانب يفتح المجال أمام هشاشة مجتمعية قد تتجاوز آثارها الضغوط الخارجية.
وتشير الخبرات الحديثة إلى أن الحروب الاقتصادية، وسلاسل التوريد، والبيانات، والعملات، باتت أدوات تأثير لا تقل أهمية عن القوة العسكرية، ما يستدعي تطوير قدرات وطنية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والأمن السيبراني، والإدارة المعرفية.
سابعًا: نحو مشروع وطني جامع
إن التحدي الأبرز يكمن في الانتقال إلى مرحلة بناء مشروع وطني متكامل، يربط بين الاقتصاد، والسياسة، والتعليم، والثقافة ضمن رؤية طويلة المدى. فغياب المشروع الجامع يترك الدولة في حالة إدارة مستمرة للأزمات دون قدرة على تجاوزها.
ويتطلب ذلك:
- صياغة رؤية اقتصادية إنتاجية، لا ريعية.
- تطوير مؤسسات التفكير الاستراتيجي وصناعة السياسات.
- تعزيز المشاركة السياسية المنظمة.
- إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس الثقة والمسؤولية المشتركة.
وفي المحصلة، لا يمكن فصل قدرة الأردن على الصمود عن قدرته في تحويل الداخل إلى مصدر قوة، بدل أن يبقى ساحة لتلقي الضغوط. فالدول التي تنجح في إدارة التحولات الكبرى ليست تلك التي تتجنب الصراعات فقط، وإنما تلك التي تبني منظومات داخلية قادرة على امتصاصها والتكيف معها.
الخاتمة:
إن ما أفضت إليه التحليلات والمناقشات في هذه الورقة يوضح أن الشرق الأوسط، مسرحًا لتصفية الحسابات، يعكس بجلاء أن الثمن الباهظ يُدفع دومًا من قبل المجتمعات الإنسانية، التي تواجه انكسارات متلاحقة على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، في حين تستمر الدول الكبرى في إعادة رسم خطوط النفوذ بما يخدم مصالحها الخاصة.
كما تنبه الورقة من أن استدامة السلام والأمن في المنطقة لن تتحقق إلا عبر استراتيجيات متعددة المستويات، تشمل تعزيز صمود الإنسان، وإعادة هيكلة المؤسسات، وتفعيل سياسات حماية الموارد الحيوية، وتطوير آليات دبلوماسية ذكية تمكن من امتصاص الأزمات وتقليل أضرارها على المجتمعات.
صادرة عن مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير