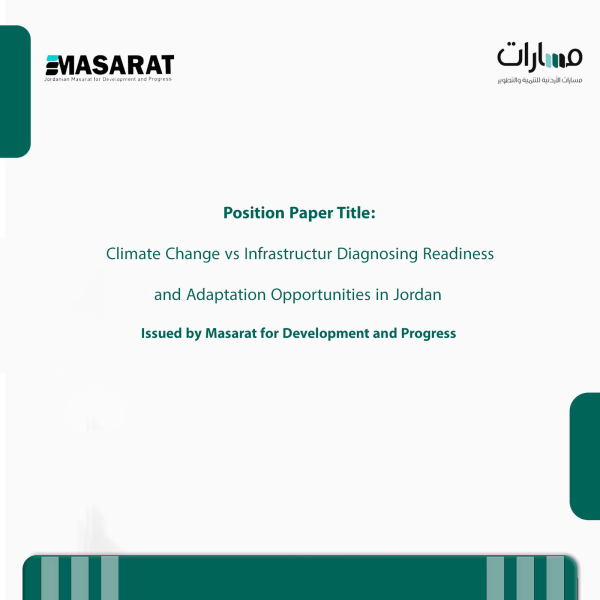ورقة موقف بعنوان: "التغير المناخي مقابل البنية التحتية… تشخيص الجاهزية وفرص التكيف في الأردن" صادرة عن مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير

المقدمة
تأتي هذه الورقة في لحظة فارقة، تتجاوز فيها الظواهر المناخية حدود "الطارئ" لتدخل نطاق "المنتظم غير المتوقع"، إذ لم تعد المشكلة في حدوث الهطولات الشديدة أو الفيضانات المفاجئة بحد ذاتها، وإنما في الفجوة المتسعة بين الواقع المناخي الجديد، وبين قدرة المنظومات التخطيطية والتنفيذية القائمة على الاستجابة والتكيّف.
تنطلق الورقة من مقاربة تحليلية محايدة، لا تسعى إلى تبسيط الإشكاليات أو تحميل المسؤوليات بصورة تجزيئية، بقدر ما تهدف إلى تفكيك المشهد كما هو، والمتمثل في بنية تحتية صُممت وفق افتراضات مناخية لم تعد قائمة، بلديات تمتلك خططًا دون أدوات تنفيذ كافية، أطر تشريعية موجودة لكن ترجمتها العملية ما تزال جزئية، وتنسيق مؤسسي قائم لكنه غير كافٍ لمواجهة مخاطر عابرة للقطاعات والاختصاصات.
وعليه، تسعى هذه الورقة إلى تقديم قراءة معمّقة للتحديات والفرص، من خلال ربط تغيّر المناخ بمفاهيم المرونة الحضرية، والاستدامة المالية، والتخطيط طويل الأمد، وصولًا إلى طرح مسارات واقعية تعزز قدرة الأردن على الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء الجاهزية، ومن الاستجابة اللاحقة إلى الوقاية الاستباقية.
الفصل الأول: التغير المناخي في الأردن... ضرورة التخلص من إدارة الطوارئ
خلال العقد الأخير، كشفت التحولات المناخية المتسارعة عن نفسها بوضوح عبر أنماط مناخية ملفتة تتمثل في موجات جفاف أطول وأكثر شدة، ارتفاعات متواصلة في درجات الحرارة، وتزايد في الهطولات المطرية الفجائية ذات الكثافة العالية، وما يصاحبها من سيول وفيضانات مفاجئة، وهذه الظواهر تحوّلت إلى سمات متكررة، ما يجعل التعامل معها بوصفها “أحداثًا طارئة” قراءة قاصرة للواقع.
تكمن الإشكالية المركزية في أن البنية التحتية الأردنية – من طرق وجسور وشبكات تصريف وسدود ومناطق حضرية – أُنشئت تاريخيًا ضمن افتراض ضمني لاستقرار المناخ، أو على الأقل لتقلبات يمكن التنبؤ بها ضمن هوامش ضيقة، ومع انهيار هذا الافتراض، باتت هذه البنية مكشوفة أمام صدمات متزايدة، تتحول معها مشاريع التنمية نفسها إلى مصادر هشاشة إضافية بدل أن تكون أدوات صمود.
ومن هنا، فإن السؤال لم يعد يدور حول حجم الأضرار الناجمة عن السيول أو موجات الجفاف، وإنما حول منطق التخطيط ذاته، فهل ما يزال الأردن يتعامل مع المناخ كعامل خارجي طارئ، أم بوصفه متغيرًا حاكمًا يجب إدماجه في قلب السياسات العامة؟، إن الفصل التقليدي بين التخطيط التنموي والاعتبارات المناخية لم يعد ممكنًا، لا من الناحية العلمية، ولا من زاوية الجدوى الاقتصادية، ولا من منظور الأمن الوطني الشامل.
تزداد هذه الإشكالية تعقيدًا في ظل معادلة اللاعدالة المناخية، حيث يُصنّف الأردن من بين الدول ذات المساهمة المحدودة في الانبعاثات العالمية، لكنه في الوقت ذاته من أكثر الدول تعرضًا لتداعياتها. هذا التناقض يضع الدولة أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في التكيّف مع واقع لم تكن سببًا رئيسيًا في صناعته، والمطالبة في الوقت ذاته بمكانة عادلة في منظومة التمويل والدعم المناخي الدولية.
في هذا السياق، تبرز الحاجة إلى الانتقال من إدارة المخاطر إلى حوكمة المناخ، أي الانتقال من منطق الاستجابة بعد وقوع الكارثة، إلى بناء منظومة سياسات استباقية قائمة على المرونة المناخية، وتكامل القطاعات، وتقدير المخاطر قبل تجسّدها، فإدماج المناخ في التخطيط للبنية التحتية يعد شرطًا أساسيًا لاستدامة الاستثمار العام وحماية الموارد المالية للدولة.
ويعني ذلك عمليًا إعادة تعريف معايير تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، بحيث تقوم على مفاهيم المرونة المناخية، والاستدامة البيئية، وكفاءة استخدام الموارد، وتقليل الانبعاثات، وتحمّل الصدمات المتوقعة مستقبلًا لا الحالية فقط، كما يستدعي دورًا أكثر فاعلية للدولة في توجيه الاستثمارات نحو مشاريع خضراء قادرة على الصمود، سواء عبر أدوات تشريعية، أو حوافز اقتصادية، أو شراكات ذكية مع القطاع الخاص.
على المستوى التشريعي، فالتشريعات المتعلقة بالمناخ والبنية التحتية تمثل خط الدفاع الأول عن حقوق الأجيال القادمة، وتُشكّل الأساس لمواءمة السياسات الوطنية مع الالتزامات الدولية، وعلى رأسها اتفاق باريس للمناخ. كما تتيح هذه التشريعات تعزيز الاقتصاد الأخضر، وتطوير نماذج الاقتصاد الدائري، وإخضاع المشاريع الكبرى لتقييمات مناخية إلزامية لا شكلية.
ولا يمكن النظر إلى العمل المناخي بمعزل عن أهداف التنمية المستدامة، إذ يشكّل الهدف الثالث عشر (العمل المناخي) الإطار الناظم لبقية الأهداف، لا مسارًا منفصلًا عنها، فالمياه، والطاقة، والغذاء، والصحة، والتنمية الحضرية، جميعها رهينة مباشرة للقدرة على إدارة المخاطر المناخية. ومن ثم، فإن إدماج المناخ في التخطيط التنموي يعزز كفاءة الإنفاق العام، ويقلل من الخسائر المستقبلية، ويحوّل التكيف والتخفيف من عبء مالي إلى استثمار في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
الفصل الثاني: من تشخيص الظاهرة إلى تفكيك خللها
شهد إدراك المجتمعات المحلية لتداعيات التغير المناخي تحولًا نوعيًا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تزايد شدتها، وتسارع وتيرتها، وانكشاف آثارها المباشرة في الفضاء العام. وقد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا حاسمًا في إعادة تشكيل هذا الإدراك؛ إذ حوّلت الأحداث المناخية من وقائع محلية معزولة إلى مشاهد عامة متداولة لحظيًا، ما عمّق الوعي المجتمعي، لكنه في الوقت ذاته أسهم في تبسيط الإشكاليات المعقدة وردّها أحيانًا إلى تفسير أحادي يختزل كل الإخفاقات تحت مظلة "التغير المناخي".
غير أن القراءة الموضوعية تقتضي التمييز بين المخاطر المناخية بوصفها معطى خارجيًا، وبين ضعف البنية التحتية بوصفها نتاجًا داخليًا لتراكمات تخطيطية وإدارية وتشريعية. فالأحداث المفصلية التي شهدها الأردن خلال العقد الأخير - من غرق مناطق حضرية رئيسية، إلى فاجعة البحر الميت، إلى السيول المتكررة في الجنوب والوسط -كشفت بوضوح عن فجوة عميقة بين الواقع المناخي الجديد، ومنظومة التخطيط والتنفيذ السائدة.
وعلى خلاف التصورات الشائعة، لا يمكن توصيف البنية التحتية الأردنية بأنها متداعية أو بدائية مقارنة بالإقليم؛ إذ تشير المؤشرات العامة إلى مستوى مقبول نسبيًا من حيث الامتداد والكفاءة الأساسية. غير أن الإشكالية الجوهرية لا تكمن في "وجود" البنية التحتية، وإنما في نوعية بنائها، ومنهجية تنفيذها، واستدامة صيانتها، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات. فابتداءً من عام 2011، تبلور نمط تخطيطي وتنفيذي قائم على منطق "الإنجاز السريع"المرتبط بدورات التمويل والمنح، وبسعي الجهات المنفذة إلى إظهار نتائج مرئية خلال مدد زمنية قصيرة، غالبًا على حساب الجودة، والدراسة المسبقة، والتقييم طويل الأمد للمخاطر.
وقد انعكس هذا المنطق بوضوح في مشاريع بنية تحتية نُفذت بمعايير دنيا، دون ربط كافٍ بالسياق الهيدرولوجي أو المناخي للمناطق المستهدفة، ما جعلها عرضة للفشل المبكر عند أول اختبار جدي. وتفاقم هذا الخلل مع ضعف منظومات الصيانة الدورية، لا سيما في البلديات وأمانة عمان الكبرى، التي تعمل ضمن قيود مالية خانقة، وديون مرتفعة، ونسب متدنية من الموازنات المخصصة للمشاريع الرأسمالية والصيانة مقارنة بحجم الشبكات الخدمية الواقعة ضمن مسؤوليتها.
في هذا السياق، يمكن تفكيك الأزمة على ثلاثة مستويات مترابطة: الإطار التشريعي، والأدوات الفنية، والحوكمة المؤسسية.
أولًا: التشريعات – النصوص الحاضرة والتطبيق الغائب
يتميّز الإطار التشريعي الأردني بوفرة القوانين والأنظمة ذات الصلة بالتنظيم العمراني، والبناء، وإدارة الموارد، والمخاطر. غير أن التحدي يكمن في قصور مواءمة النصوص مع الواقع المناخي المستجد، وضعف إلزاميتها التنفيذية. فعلى الرغم من تطوير كودات هيدرولوجية متقدمة، وإقرارها رسميًا بعد عام 2019، إلا أنها بقيت في كثير من الأحيان وثائق "موجودة على الرف"، لا تُطلب إلزاميًا عند إعداد المخططات الهيكلية أو تنفيذ المشاريع الكبرى.
وينسحب الأمر ذاته على الخرائط المناخية وخرائط مخاطر الفيضانات ومسارات الأودية، التي أُنجزت بجهود وطنية ودولية، لكنها لم تتحول إلى أدوات حاكمة في قرارات التخطيط والتنظيم. ويُضاف إلى ذلك غموض بعض المفاهيم القانونية، مثل تعريف "المناطق الخطرة" أو "حرم الوادي"، ما يفتح المجال لتفسيرات مرنة تخضع أحيانًا لضغوط اجتماعية أو اعتبارات آنية، خصوصًا في المدن خارج العاصمة.
ثانيًا: الأدوات الفنية – فجوة التحديث والتشغيل
على المستوى الفني، لا تزال أنظمة البناء والكودات المعتمدة تعاني من تفاوت زمني كبير، إذ يعود بعضها إلى عقود سابقة، ولم يُحدّث بما ينسجم مع السيناريوهات المناخية الجديدة. كما أن ضعف التكامل بين الكودات، وغياب الربط الإلزامي بينها وبين دراسات تقييم المخاطر المناخية، يقلل من فعاليتها العملية، حتى عندما تكون متقدمة نظريًا.
ثالثًا: الحوكمة المؤسسية – تعدد الجهات وغياب المرجعية
ربما تكمن الإشكالية الأعمق في تشظي المسؤوليات المؤسسية. فالأحداث المناخية الكبرى كشفت عن تداخل صلاحيات بين وزارات وهيئات وبلديات وسلطات متخصصة، دون وجود مرجعية وطنية واحدة تتولى التخطيط المتكامل للمخاطر المناخية. هذا التعدد لا يؤدي فقط إلى إرباك في الاستجابة، بل يخلق بيئة لتبادل المسؤوليات وتآكل المساءلة.
ويُضاف إلى ذلك ضعف بناء القدرات على المستوى المحلي، لا سيما في البلديات، في مجالات تحليل المخاطر، والتخطيط الاستباقي، وإدارة البيانات. كما تعاني بعض المؤسسات من تشتت قواعد البيانات المناخية والهيدرولوجية، حيث تمتلك كل جهة أرقامها ومؤشراتها الخاصة، ما يعيق بناء صورة وطنية موحدة للمخاطر.
وفي هذا الإطار، تبرز الحاجة إلى إشراك النقابات المهنية، والجامعات، ومراكز البحث، بوصفها شركاء معرفيين لا أطرافًا هامشية. فغياب هذا التكامل يحرم صانع القرار من تراكم معرفي وطني قادر على تحويل التخطيط العمراني من أداة توسع أفقي إلى منظومة إدارة مخاطر شاملة.
في المحصلة، لا تعكس أزمة البنية التحتية في الأردن عجزًا تقنيًا بقدر ما تكشف عن اختلال في فلسفة التخطيط والإدارة. فالتحدي الحقيقي يتمثل في إعادة تعريف مفهوم الإنجاز، من إنجاز شكلي قصير الأمد، إلى إنجاز وظيفي مستدام يقاس بقدرته على الصمود، وطول عمره التشغيلي، وتخفيضه للكلفة المستقبلية على الدولة والمجتمع. ومن دون هذا التحول، ستظل التغيرات المناخية عاملًا كاشفًا، لا سببًا وحيدًا، لاختلالات أعمق في منظومة التنمية الحضرية والحوكمة العامة.
الفصل الثالث: فجوة الرقابة والمساءلة
إذا كانت التشريعات تشكّل الإطار الناظم، والكودات والأدوات الفنية تمثل الأساس المهني، فإن الرقابة الفاعلة هي الحلقة الحاسمة التي تحدد ما إذا كانت السياسات تتحول إلى واقع أم تبقى حبرًا على ورق. وفي الحالة الأردنية، تكشف التجارب الميدانية المتراكمة أن الخلل الأكبر يكمن في ضعف منظومة الرقابة الشاملة، وخصوصًا الرقابة ما بعد التنفيذ، وهي المرحلة التي غالبًا ما تُهمل، رغم كونها الأكثر تأثيرًا على السلامة العامة واستدامة البنية التحتية.
تُظهر حالات متكررة – كما في مناطق حضرية قديمة وحديثة على حد سواء – كيف تحوّلت مسارات سيول تاريخية معروفة إلى شوارع مرخّصة، ثم إلى مناطق سكنية مكتظة، بتواقيع رسمية وموافقات تنظيمية صادرة عن جهات محلية. المفارقة هنا أن الدولة، ممثلة ببلدياتها ومؤسساتها التنظيمية، شاركت فعليًا في إنتاج الخطر، عبر منح تراخيص وبناء شبكات طرق وخدمات فوق مسارات طبيعية للمياه، ثم عادت لاحقًا لتُحمّل المواطن مسؤولية البناء في "مناطق خطرة"، في تناقض صارخ بين الفعل الإداري والخطاب الرسمي.
هذا الخلل لا يمكن عزله عن طبيعة العمل البلدي والإداري، حيث تتداخل أحيانًا الاعتبارات المهنية مع ضغوط اجتماعية وانتخابية، أو ما يُعرف بثقافة "الخواطر"، على حساب مقتضيات السلامة العامة والتخطيط طويل الأمد. وبدل أن تكون الرخصة أداة ضبط وتنظيم، تحوّلت في بعض الحالات إلى أداة ترحيل للمخاطر إلى المستقبل، لتظهر آثارها بعد سنوات أو عقود، حين تصبح كلفة المعالجة أضعاف كلفة المنع.
ويُضاف إلى ذلك ضعف الرقابة أثناء التنفيذ، حيث تُنفّذ مشاريع بنية تحتية بمعايير أقل من تلك المعتمدة نظريًا، دون فحوصات كافية، أو إشراف ميداني صارم، أو مساءلة حقيقية للمقاول والاستشاري، أما الرقابة ما بعد التنفيذ – وهي الأهم – فتكاد تكون الحلقة الأضعف، إذ نادرًا ما تُراجع المشاريع بعد تسليمها للتأكد من أدائها الفعلي، أو من مدى مطابقتها للتصاميم والكودات، أو من جاهزيتها لمواجهة سيناريوهات مناخية غير اعتيادية.
في هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن التغير المناخي لا يعمل في فراغ، فهو يضخّم آثار أخطاء بشرية متراكمة، ذلك أن الهطولات الشديدة، أو السيول المفاجئة، أو ارتفاع درجات الحرارة، تصبح كارثية حين تصطدم ببنية تحتية أُنشئت دون اعتبار كافٍ للجيولوجيا المحلية، أو لطبيعة التربة الهشة، أو لوجود فراغات وانهدامات طبيعية في مناطق واسعة من الأردن، لا سيما على امتداد صدع الانهدام العظيم. وهي معطيات معروفة علميًا، لكنها لا تُترجم دائمًا إلى قرارات تنفيذية صارمة.
وتبرز هنا إشكالية العامل البشري، ليس من حيث النوايا، وإنما من حيث الكفاءة، والتخصص، والمسؤولية. فالتعامل مع قضايا معقدة كتغير المناخ، وإدارة المياه، واستقرار التربة، لا يمكن اختزاله في تخصص واحد أو لجنة شكلية، وإنما يتطلب فرقًا متعددة التخصصات تضم مهندسين، وجيولوجيين، وخبراء هيدرولوجيا، ومخططين حضريين، ضمن منظومة قرار مؤسسية واضحة. وغياب هذا التكامل يؤدي إلى حلول جزئية، أو مشاريع شكلية، أو مبادرات تُقاس بعددها لا بأثرها.
وينسحب الأمر ذاته على بعض البرامج البيئية، كالتشجير أو التدخلات السريعة، التي تُنفذ أحيانًا دون تخطيط مكاني صحيح، أو دراسة أثر، أو انسجام مع شبكة الطرق والبنية التحتية، ما يحوّلها من أدوات تخفيف للمخاطر إلى عناصر إرباك جديدة. فالتخطيط البيئي، كما التخطيط العمراني، ليس فعل استجابة آنية، بل عملية تراكمية تُقاس بقدرتها على الصمود لا بسرعة الإعلان عنها.
في المحصلة، تكشف أزمة الرقابة في ملف البنية التحتية والتغير المناخي عن أزمة أعمق في الحوكمة العامة، تتمثل في غياب المساءلة المتسلسلة من القرار إلى التنفيذ إلى التقييم. فالمواطن، في نهاية المطاف، لا يعنيه توصيف الظاهرة بقدر ما يعنيه ألا يتعرض منزله أو طريقه أو مصدر رزقه للخطر. ومن هنا، فإن استعادة الثقة بين الدولة والمجتمع تمر حتمًا عبر إعادة بناء منظومة رقابية مستقلة، مهنية، ومتخصصة، تضع السلامة العامة فوق الاعتبارات الآنية، وتحوّل التخطيط بعيد المدى من شعار إلى ممارسة مؤسسية ملزمة.
الفصل الرابع: من المشاريع الرمزية إلى التخطيط القائم على الأثر
تكشف التجربة الأردنية في التعامل مع التغير المناخي والبنية التحتية، أن الإشكالية الجوهرية تتمثل في الفجوة العميقة بين النية والتنفيذ، وبين الإعلان والأثر الفعلي على الأرض. وهي فجوة تُدار في كثير من الأحيان بعقلية استعراضية، تُقدّم "المشهد" على "المنظومة"، وتركّز على التدخلات السريعة ذات العائد الإعلامي، بدل الاستثمار في حلول مستدامة، متكاملة، وقابلة للصمود.
فمشاريع التشجير، على سبيل المثال، تُقدَّم غالبًا بوصفها استجابة بيئية إيجابية، لكنها في غياب منظومة ريّ مستدامة، ودراسة ملاءمة الموقع، وخطة صيانة طويلة الأمد، تتحول إلى مبادرات موسمية قصيرة العمر، تنتهي بمجرد انتهاء الفعالية أو جفاف الخزانات المؤقتة.
ويمتد هذا الخلل إلى قرارات إدارية أوسع، تتعلق بإلغاء بنى قائمة أو تغييرها بدوافع شكلية أو ذوقية، دون احتساب الكلفة - المنفعة، أو تقييم الأثر طويل الأمد. فاستبدال حلول بنية تحتية وظيفية، أو إزالة عناصر حماية فعّالة، لصالح مشاريع أكثر "جاذبية بصريًا"، يعكس أزمة في فلسفة الإدارة العامة، حيث يُستبدل التفكير المؤسسي بمنطق القرار الفردي، وتتراجع الاستمرارية لصالح القطيعة، ويتحوّل التغيير من تطوير تراكمي إلى إعادة اختراع غير ضرورية.
وفي المقابل، تُظهر المقارنات الدولية، حتى مع دول ذات موارد محدودة، أن الفارق الحقيقي لا تصنعه الإمكانات، وإنما جودة الحوكمة. فالمدن التي نجحت في بناء مظلات خضراء، ومسارات حضرية صالحة للمشاة، وبنية تحتية مرنة، فعّلت ذلك عبر تراكم سياسات منضبطة، تحترم التخطيط، وتُقدّر التخصص، وتستثمر في الإنسان قبل الحجر.
وهنا تبرز إشكالية العامل البشري والاختيار الوظيفي. فالتعامل مع ملفات معقدة كالتغير المناخي، والتخطيط الحضري، وإدارة المخاطر، لا يحتمل منطق المجاملة أو المحاصصة أو التزكية غير المهنية. إذ إن إقصاء الكفاءات، أو تهميش أصحاب الاختصاص الدقيق، مقابل تعيينات قائمة على القرب أو الولاء، يؤدي بالضرورة إلى تشوّه القرار العام، وإلى حلول مبتورة لا تعكس حجم التحديات الفعلية.
ويتضح هذا الخلل بجلاء في التخطيط العمراني، حيث شهد الأردن تمددًا حضريًا متسارعًا، أملته عوامل ديمغرافية وسياسية مفاجئة، كالهجرات واللجوء، دون أن يواكبه تخطيط استباقي كافٍ. فكانت النتيجة توسعات عمرانية عشوائية، و”تمدّدًا إسمنتيًا” على حساب الأحواض المائية، ومسارات السيول، والمناطق الهشة جيولوجيًا. ورغم توفر كودات البناء، وشروط التنظيم، والتشريعات البلدية، إلا أن ضعف إنفاذ القانون جعل هذه الأدوات عاجزة عن أداء وظيفتها.
ولا يمكن فصل ذلك عن غياب الدمج الحقيقي للبعد المناخي في التخطيط الحضري. فالتغير المناخي ليس حدثًا طارئًا، بل تحول بنيوي طويل الأمد، يتطلب إعادة تقييم شاملة للهشاشة الحضرية، وقدرة المدن على التكيف، من حيث البنية التحتية، والمساحات العامة، وإدارة المياه، والعدالة المكانية. ومع أن الأردن أعدّ تقارير وطنية، وسيناريوهات علمية تمتد حتى نهاية القرن، إلا أن هذه المعرفة لا تزال حبيسة الوثائق، ولم تُترجم بعد إلى سياسات تنفيذية ملزمة على مستوى البلديات والقطاعات المختلفة.
وتزداد خطورة هذا الخلل حين يُستبعد البعد العلمي، ولا سيما الجيولوجي، من مشاريع كبرى، أو حين يُتعامل مع تحذيرات الخبراء بوصفها عوائق لا أدوات وقاية. فالتاريخ العمراني للأردن، كما في مواقع أثرية صمدت قرونًا، يؤكد أن البناء المنسجم مع الطبيعة أكثر قدرة على البقاء من التدخلات الحديثة التي تجاهلت خصائص التربة والضغط الجيولوجي، فأعادت توجيه المخاطر بدل احتوائها.
في المحصلة، يبيّن هذا الفصل أن التحدي الحقيقي أمام الأردن في مواجهة التغير المناخي لا يكمن في نقص الخطط أو غياب التمويل الدولي أو ضعف الوعي العام، بل في إعادة تعريف مفهوم الإدارة العامة نفسها: من إدارة ردود الأفعال إلى إدارة المخاطر، ومن مشاريع رمزية إلى سياسات قائمة على الأثر، ومن قرارات فردية إلى حوكمة مؤسسية، ومن تخطيط قصير النفس إلى رؤية زمنية تمتد لعقود.
ودون هذا التحول البنيوي، ستبقى الجهود مبعثرة، والنتائج محدودة، وستتحول التغيرات المناخية من تحدٍّ يمكن التكيّف معه، إلى عامل كاشف لأزمات أعمق في التخطيط، والإدارة، والعدالة الحضرية.
الفصل الخامس: ماذا ينبغي أن نفعل؟
ينطلق سؤال "ماذا ينبغي أن نفعل؟" في سياق التغير المناخي والبنية التحتية، بوصفه سؤالًا يتصل مباشرة بقدرة الدولة والمجتمع على بناء المرونة المناخية، أي القدرة على الامتصاص، والتكيف، والاستمرار، في ظل أنماط مناخية متغيرة باتت أكثر تكرارًا، وأكثر حدّة، وأقل قابلية للتنبؤ.
التقييم الواقعي للبنية التحتية في الأردن يشير إلى أنها ليست منهارة، لكنها غير مهيأة بالكامل لمواجهة التحولات المناخية القادمة. فالإشكالية لم تعد في كميات الهطول المطري السنوية بحد ذاتها، وإنما في تغير نمط الهطول، والمتمثلة في انتقال الأمطار من توزيع زمني ممتد على أيام، إلى عواصف قصيرة ومكثفة خلال ساعات، وتحول مركز الثقل المناخي باتجاه الشرق والجنوب، وهذا التحول يفرض ضغوطًا تتجاوز القدرة التصريفية التي صُممت على أساسها شبكات قائمة، بُنيت وفق افتراضات مناخية لم تعد صالحة.
ومع ذلك، فإن هذه التحديات لا تُعد غير قابلة للحل، فالحلول الفنية، من حيث المبدأ، معروفة ومجربة، الصيانة الدورية العميقة للبنية التحتية، إعادة تأهيل شبكات التصريف، توسيع الأقطار الحرجة، دمج حلول الطبيعة (Nature-Based Solutions)، وتعزيز حصاد المياه، لا سيما في المناطق الصحراوية والهامشية.
وتبرز هنا إشكالية التمويل المحلي، خصوصًا على مستوى البلديات. فرغم إعداد خطط مرونة مناخية لعدد من البلديات الكبرى، بدعم وشراكة دولية، إلا أن فجوة التنفيذ لا تزال قائمة، نتيجة محدودية الموارد المالية، وعدم مواءمة آليات التمويل مع حجم الأعباء الواقعة على البلديات. ويتضاعف هذا التحدي في ظل تعدد الجهات وتداخل الصلاحيات داخل الحيز الجغرافي الواحد، ما يؤدي إلى تفتيت المسؤولية، وإرباك القرار، وتحميل البلديات أعباء تشغيلية وبنيوية لا تتناسب مع صلاحياتها الفعلية.
وفي المقابل، تشير الجهود الوطنية إلى وجود بنية تنسيقية رسمية، من خلال لجان وطنية لتغير المناخ، وأطر سياسات شاملة، تمتد زمنيًا حتى عام 2050، وتغطي القطاعات الحيوية كافة: الطاقة، والمياه، والصحة، والإدارة المحلية. وقد أسهم هذا الإطار في إدماج البعد المناخي ضمن الاستراتيجيات القطاعية، وتفكيك المفهوم التقليدي للتغير المناخي بوصفه شأنًا بيئيًا معزولًا، لصالح مقاربة شمولية عابرة للقطاعات.
غير أن هذا التقدم المفاهيمي لا يزال يصطدم بواقع التنفيذ، حيث تتفاوت قدرات المؤسسات المحلية، ويغيب أحيانًا الربط الفعلي بين التخطيط الوطني والاحتياجات اليومية للمجتمعات الحضرية. كما أن تحويل البلديات من جهات خدمية مثقلة بالعجز، إلى فاعلين في التكيف المناخي، يتطلب إعادة تصميم نماذج التمويل، والاستفادة من أدوات غير تقليدية، مثل مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، وأسواق الكربون، بما يخفف الضغط على الموازنات التشغيلية، ويخلق موارد ذاتية مستدامة.
في هذا السياق، تبرز مقاربة حصاد المياه كأحد الخيارات الاستراتيجية ذات الجدوى العالية، كأداة مزدوجة لتعزيز الأمن المائي، ودعم المجتمعات المحلية، والحياة البرية، والمخزون الجوفي، حتى وإن كانت هذه المنشآت موسمية أو قصيرة العمر. فالتعامل مع كل قطرة ماء بوصفها موردًا، لا تهديدًا، يمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة إدارة المخاطر.
ومع ذلك، لا يمكن تجاهل صوت النقد الذي يشير بوضوح إلى أن البنية التحتية الحالية لا تواكب بعد حجم التحدي المناخي القادم، وأن الاستمرار في خطاب الاطمئنان قد يُفضي إلى تقليل الاستعداد لموجات أشد، سواء من حيث الفيضانات المفاجئة، أو العواصف الغبارية، أو موجات الحر.
إن وضع "الإصبع على الجرح"، يمثل الشرط الأول لأي تحول حقيقي، فبدون الاعتراف بالفجوة بين ما هو مخطط وما هو مطبق، ستبقى السياسات حبيسة الوثائق، وستظل المدن عرضة لامتحانات مناخية متكررة، قد لا يكون هامش الخطأ فيها متاحًا في المستقبل القريب.
الفصل السادس: المتاح أمام القادم؟
تشير المؤشرات العلمية والرصد الميداني إلى تغيّر واضح في اتجاهات الكتل المطرية نحو الشرق والجنوب، وما يرافق ذلك من زيادة احتمالية الفيضانات الخاطفة (Flash Floods)، وهذا التحوّل يضع شبكات تصريف مياه الأمطار، التي صُمّمت وفق معايير مناخية سابقة، أمام اختبارات قاسية تتجاوز افتراضاتها التصميمية. وعليه، فإن الإشكالية ليست في "وجود" بنية تحتية، بل في "ملاءمتها" وقدرتها على الصمود في وجه سيناريوهات مناخية أكثر تطرفًا.
ومع أن جزءًا معتبرًا من البنية التحتية في المدن الأردنية يُعدّ مقبولًا من حيث الأساس الهندسي، إلا أن تراجع أعمال الصيانة الدورية، وغياب التحديث المستند إلى بيانات مناخية حديثة، يجعلان هذه البنية عرضة للفشل الوظيفي عند أول اختبار جدي، ويزداد الأمر تعقيدًا حين تتداخل عوامل التحضّر السريع، والتمدّد العمراني غير المنضبط، مع محدودية المساحات المفتوحة القادرة على امتصاص مياه الأمطار.
تُعدّ إشكالية تعدّد الجهات وتداخل الصلاحيات في الحيز الجغرافي الواحد من أبرز العوائق أمام بناء استجابة فعّالة للتغيّر المناخي. ففي مناطق صناعية وحضرية، تتقاسم بلديات، وهيئات مدن صناعية، وأمانات كبرى، ومؤسسات مركزية، مسؤوليات التخطيط والتنفيذ والصيانة، دون إطار حوكمي مندمج يضمن وحدة القرار وتكامل التدخلات، وهذا التفكك المؤسسي يفضي إلى "مناطق معلّقة" تنظيميًا، تتحمّل فيها البلديات أعباء تشغيلية ومرورية وبيئية تفوق مواردها وصلاحياتها.
على الرغم من إعداد خطط تكيف حضري وخطط مرونة مناخية لعدد من البلديات الكبرى، بالتعاون مع جهات دولية وإقليمية، إلا أن القدرة على الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ تبقى محدودة بفعل القيود المالية. فالبلديات، حتى عندما تمتلك الرؤية والخطة، تفتقر في كثير من الأحيان إلى التمويل الكافي لتحديث شبكات التصريف، أو توسيع أقطار العبارات، أو تنفيذ حلول قائمة على الطبيعة (Nature-based Solutions).
في مواجهة هذه التحديات، شهد الأردن خلال السنوات الأخيرة تطورًا مؤسسيًا لافتًا، تمثّل في إقرار نظام التغيّر المناخي وتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزير البيئة وعضوية ممثلين عن ستة عشر وزارة ومؤسسة محلية، وقد أتاح هذا الإطار تعزيز التنسيق بين القطاعات، وإدماج اعتبارات التغيّر المناخي في السياسات القطاعية، بما في ذلك الطاقة، والمياه، والصحة، والإدارة المحلية.
كما جرى اعتماد سياسة وطنية شاملة للتغيّر المناخي تمتد حتى عام 2050، تتضمن مسارات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، إلى جانب إعداد خطط تكيف قطاعية، وخطط خاصة بالبلديات، تراعي خصوصية كل مدينة وسياقها الجغرافي والسكاني.
رغم هذا التقدم، يبقى التحدي الأساسي في ترجمة السياسات والاستراتيجيات إلى تدخلات ملموسة على الأرض. فالتغيّر المناخي بات مسألة أمن وطني، واقتصادي، ومعيشي تمسّ صميم حياة المواطنين. إن غرق وسط مدينة، أو تعطّل شبكة طرق رئيسية، لا يُعدّ حادثًا عرضيًا، بل مؤشرًا على خلل هيكلي في التخطيط الحضري.
من هنا، تبرز الحاجة إلى مقاربة أكثر جرأة وواقعية، تقوم على تحديث المعايير والمواصفات الهندسية وفق سيناريوهات مناخية متشددة؛ توسيع الاعتماد على الحصاد المائي والحفائر في المناطق الحضرية وشبه الصحراوية؛ الاستثمار في إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة كمصدر تمويلي بديل عبر أرصدة الكربون؛ وتعزيز قدرات البلديات الفنية والمالية بوصفها خط الدفاع الأول في مواجهة آثار التغيّر المناخي.
الخاتمة
إن مواجهة تغيّر المناخ لا يمكن أن تتحقق عبر حلول إنشائية معزولة، أو تدخلات مجتزأة، وإنما يستدعي مقاربة شاملة تعيد الاعتبار للتخطيط المتكامل، وتوحيد المرجعيات، وتعزيز اللامركزية المدعومة بالتمويل والقدرات، وربط البنية التحتية التقليدية بحلول قائمة على الطبيعة، بما يخفف الضغط عن الشبكات القائمة ويزيد من قدرتها الاستيعابية على المدى المتوسط والطويل.
كما تبرز الحاجة إلى الانتقال من منطق إدارة الطوارئ إلى منطق إدارة المخاطر، ومن ردّ الفعل إلى الفعل الاستباقي، عبر الاستثمار في البيانات المناخية الدقيقة، وتحديث المعايير الهندسية، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة تمكّن البلديات من تنفيذ خططها بدل الاكتفاء بإعدادها.
صادرة عن مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير
17/1/2026