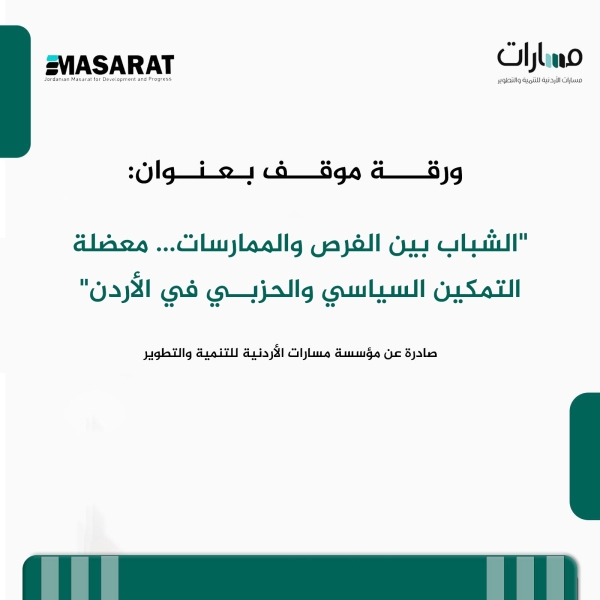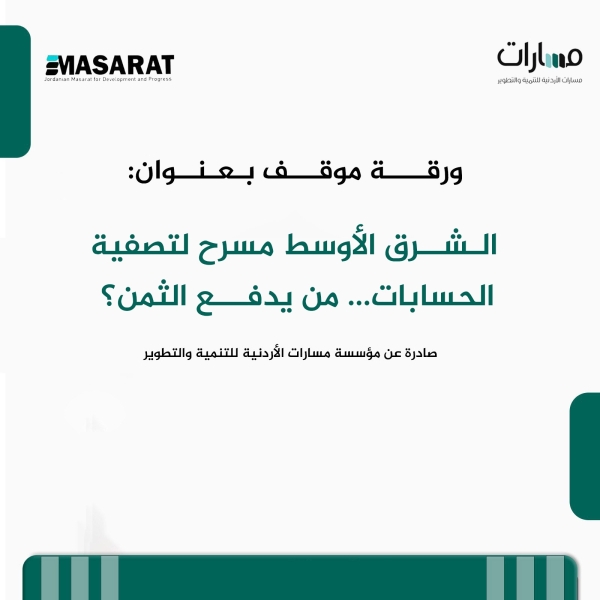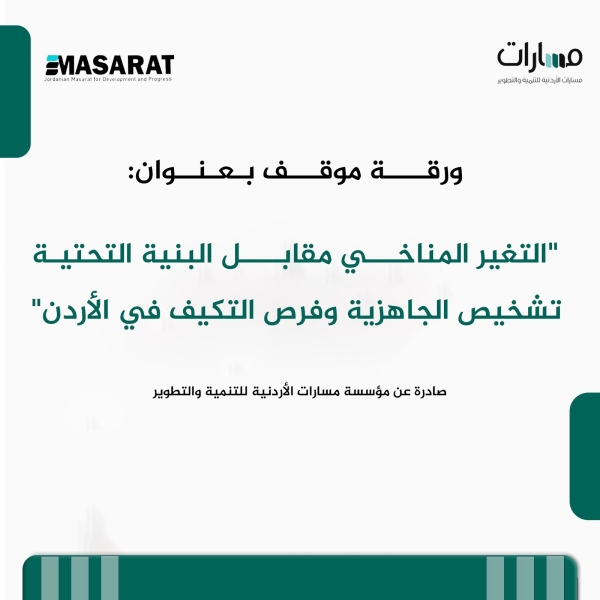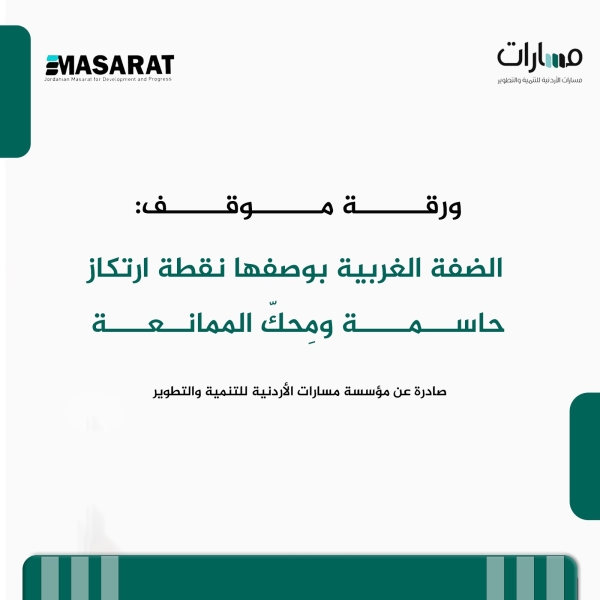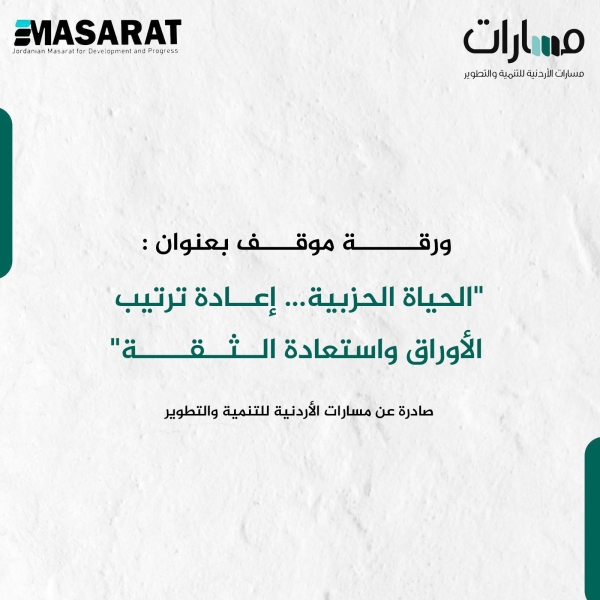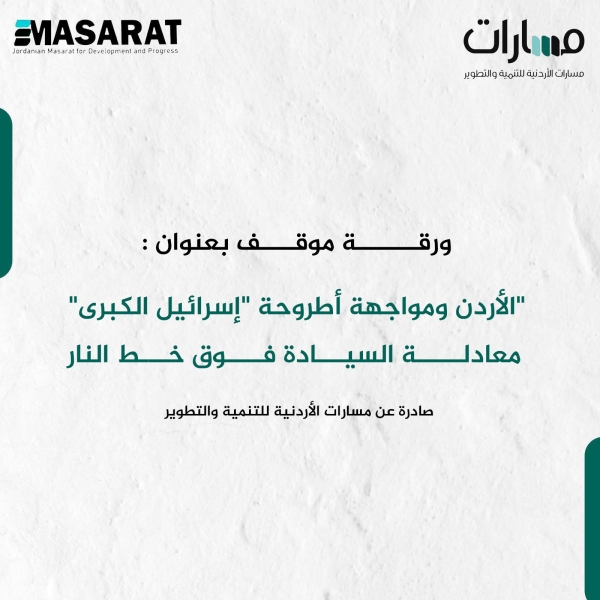ورقة موقف بعنوان: "الأردن وتعريف الخطر.. محددات التحالفات واستحقاقات الداخل"

نضع ورقة الموقف: "الأردن وتعريف الخطر.. محددات التحالفات واستحقاقات الداخل"، الأردن في بؤرة المشهد الإقليمي المضطرب، إذ تتقاطع العوامل الجغرافية، والسياسية، والديموغرافية لتنتج شبكة بالغة التعقيد، تجعل المملكة في قلب معادلة أمنية وسياسية محفوفة بالتهديدات. فالخطر تحول إلى استحقاق وجودي يُعاد إنتاجه كلما عادت مشاريع الضم والتهجير إلى الواجهة، ليشكّل هذا الملف تحديدًا نقطة ارتكاز لا يمكن فصلها عن محددات الأمن الوطني الأردني.
إن الجوار الجغرافي المباشر مع الضفة الغربية، وما يحمله من تداعيات ديموغرافية متشابكة، فضلًا عن الدور التاريخي والديني للمملكة في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، جميعها عوامل تجعل من أي تغيير في البنية الفلسطينية ليس حدثًا معزولًا، بقدر ما يمثل زلزالًا استراتيجيًا تتردد ارتداداته العميقة في صميم الاستقرار الأردني الداخلي.
ورقة موقف بعنوان: "الأردن وتعريف الخطر.. محددات التحالفات واستحقاقات الداخل"
صادرة عن مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير
المقدمة
إن قراءة المشهد الإقليمي الراهن تستلزم الغوص في شبكة معقدة من العوامل الجغرافية والسياسية والديموغرافية، التي تجعل الأردن في قلب معادلة أمنية وسياسية مهددة بالتفكك والانفجار، فمشروع الضم والتهجير، وإن بدا فكرة تعود إلى السطح على نحوٍ دوري، فإنه يظل من الملفات التي ترتبط بالأمن الوطني الأردني، بحكم الجوار الجغرافي المباشر مع الضفة الغربية، وتشابك التركيبة السكانية، والدور التاريخي والديني للمملكة في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومن هنا، فإن أي تغيير في الوضع الفلسطيني لا يُقرأ إلا بوصفه زلزالًا استراتيجيًا يصيب بنية الاستقرار الداخلي الأردني في جوهرها.
الفصل الأول: الأردن وتعريف الخطر
يواجه الأردن أربعة تهديدات رئيسية تتشابك في مفاعيلها:
فأولها، تقويض حل الدولتين، إذ إن معظم التحليلات الدولية المعاصرة تكاد تُجمع على أن هذا الحل أصبح خطابًا سياسيًا يوظَّف للتسويف أكثر من كونه خطة قابلة للتطبيق، ويعني ذلك أنّ الأردن يجد نفسه أمام تحديات مباشرة تطال الاستقرار السياسي الداخلي وتضعف شرعية المسارات الدبلوماسية التقليدية.
أما ثانيها، فهو تصاعد العنف في الأراضي المحتلة، الذي يتراوح بين العمليات المسلحة، والتوترات الحدودية، وردود الفعل الانتقامية، وهو ما يرفع من مستوى التهديد الأمني الذي قد يمتد إلى الداخل الأردني.
ويتمثل ثالثها في أي تغيير قانوني على وضع الضفة الغربية في حال أقدمت إسرائيل على الضم، الأمر الذي يفرض واقعًا جديدًا على الدبلوماسية الأردنية، ويستلزم إعادة صياغة السياسات الاقتصادية والأمنية ضمن بيئة شديدة السيولة.
أما رابعها، فيتمثل في سيناريو التهجير والضغط الديموغرافي، الذي يهدد الأردن اقتصاديًا واجتماعيًا في آن واحد، لا سيما في ظل محدودية الموارد، وبالأخص المياه، وهي التي تشكّل خط الدفاع الأول في معادلة الاستقرار الوطني.
قيود التحالفات ومعضلة الاعتماد على الذات
لا يزال الموقف الأردني أسيرًا لشبكة التحالفات التقليدية، وعلى رأسها العلاقة مع الولايات المتحدة التي تُعَد الضامن الأبرز لتوفير الموارد الحيوية والدعم العسكري، غير أنّ الأحداث الأخيرة أثبتت أنّ الاعتماد الأحادي على الضامن الأمريكي لم يعد كافيًا، لا سيما مع انكشاف محدودية المظلة الخليجية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، ومن ثمّ، فإن استراتيجيات الأردن المستقبلية تستوجب البحث عن بدائل موازية، إقليمية ودولية، تمنحه هوامش أوسع لحماية مصالحه، من دون أن يفرط في التزاماته الاستراتيجية القائمة.
السيناريوهات المحتملة
المسارات المستقبلية يمكن تلخيصها في ثلاثة احتمالات كبرى:
الأول، السيناريو الكارثي أو "البطة السوداء"، حيث يتم الضم والتهجير بدعم أمريكي وصمت دولي، ما يضع الأردن أمام واقع شديد التعقيد، يفرض عليه التكيف القسري دون قدرة على المناورة.
الثاني، السيناريو المتوسط، وهو استمرار عمليات الضم التدريجي والتهجير الناعم، وهو ما يعني تحديات مزمنة تتطلب إدارة دقيقة للأمن الداخلي وتعزيز أدوات الاقتصاد والدبلوماسية.
الثالث، السيناريو الإيجابي، الذي قد يتمثل في نجاح الضغوط الدولية في ردع إسرائيل وإعادة إطلاق عملية سياسية، وهو احتمال ضعيف، لكنه يظل ممكنًا في حال فرضت صدمات ميدانية عنيفة إعادة النظر في موازين القوى، كما جرى بعد حربَي 1967 و1973.
أدوات لا بد من الاستثمار بها
إن استيعاب طبيعة المخاطر يفرض على الأردن تبني مقاربة متعددة الأدوات:
- تعزيز عناصر القوة غير العسكرية، وفي مقدمتها الاقتصاد والإعلام والدبلوماسية كخطوط دفاع أمامية.
- تحصين الجبهة الداخلية عبر توسيع قاعدة المشاركة الوطنية، وتقليص التهميش الاجتماعي والسياسي، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
- الإبقاء على السلطة الفلسطينية، ولو بوصفها مظلة إدارية، بما يحول دون انهيار كامل يقود إلى فوضى عابرة للحدود.
السياق الإقليمي والدولي
تؤكد المعطيات أن غياب مشروع عربي موحد لمواجهة التحولات الجارية سمح للمشروع الصهيوني المدعوم أمريكيًا بالتمدد، في ما يمكن تسميته "مرحلة الصهيونية الجديدة"، ولا يُنظر إلى الأردن هنا بوصفه هدفًا عسكريًا مباشرًا، وإنما باعتباره ساحة مرشحة لممارسة الضغوط الديموغرافية الناعمة، التي قد تغيّر بنيته السكانية وتزيد من هشاشته الداخلية، ومن ثم، فإن الرهان على موقف عربي جامع يبدو وهميًا، وهو ما يستوجب أن يرتكز أي تخطيط استراتيجي أردني على تعزيز متانة الداخل وصياغة بدائل اقتصادية وسياسية مستقلة.
وبذلك يتضح أن التحدي الحقيقي أمام الأردن في صياغة معادلة داخلية صلبة تمكّنه من الصمود في وجه مشروع إعادة تشكيل المنطقة، الذي يتعامل مع الأردن باعتباره الخاصرة الأضعف في معركة الضم والتهجير.
الفصل الثاني: الأردن بين مأزق التحالفات الخارجية واستحقاقات الداخل
إن قراءة دقيقة للمشهد الأردني الراهن تكشف عن واقع معقّد تتداخل فيه الأبعاد الاقتصادية، والسياسية، والأمنية، والاجتماعية ضمن منظومة مترابطة لا يمكن تفكيكها أو النظر إليها بمعزل عن بعضها البعض، فالأردن، وهو يقف على تماس مباشر مع بؤر الصراع الإقليمي، يجد نفسه اليوم أمام معادلة صعبة، فإما أن يعيد إنتاج استراتيجيته الوطنية على أسس أكثر صلابة، أو أن يظل عالقًا في فضاء من الارتهان والهشاشة، عرضة لضغوط تتجاوز قدرته على الاحتمال.
أولًا: المعضلة الاقتصادية والتكامل العربي الغائب
ليس خافيًا أن الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الأردن تعد انعكاسًا مباشرًا لغياب منظومة عربية تكاملية حقيقية، فحين يُترك بلد محوري بحجم الأردن يواجه أزماته منفردًا، في وقت تتسابق فيه بعض الدول الغنية على بناء مدن عملاقة وناطحات سحاب تفوق كلفتها بأضعاف ما يحتاجه الأردن لسد فجواته، فإن الرسالة الواضحة هي أن غياب النية للتكامل - ولو في حدوده الدنيا - أصبح هو القاعدة الناظمة للعلاقات العربية – العربية، ومن ثمّ، تتجاوز الأزمة بعدها المالي لتتجلى كأزمة سياسية تتعلق بطبيعة النظام الإقليمي نفسه.
ثانيًا: معاهدة وادي عربة ومحدودية البدائل
تشكل معاهدة وادي عربة عقدة استراتيجية في معادلة الأمن الأردني؛ فهي، وإن كانت عبئًا سياسيًا وشعبيًا، إلا أن إلغاؤها في الظرف الراهن يُقارب إعلان الحرب، وهي حرب لا يملك الأردن - ولا الإقليم - القدرة على تحمل تبعاتها، والمفارقة أن المشكلة لا تكمن في إسرائيل وحدها، وإنما في المظلة الأمريكية التي تحميها وتمنحها الغطاء الاستراتيجي، وعليه، يصبح التعاطي مع المعاهدة رهينًا بميزان بالغ الدقة بين الرغبة في التحرر من قيودها والضرورة الواقعية لعدم الانزلاق إلى مواجهة شاملة غير محسوبة العواقب.
ثالثًا: السلطة الفلسطينية بين إضعاف الدور وإعادة التوظيف
إن مساعي إضعاف السلطة الفلسطينية جزء من استراتيجية إسرائيلية -أمريكية تهدف إلى نزع الشرعية السياسية عن أي كيان فلسطيني، وتحويل السلطة إلى مجرد إدارة مدنية محدودة الصلاحيات، ومع ذلك، يبدو أن بقاءها ضرورة مرحلية، إذ تُستخدم كإطار إداري لاحتواء الديموغرافيا الفلسطينية داخل المدن والقرى، فيما تبقى السيادة الفعلية بيد الاحتلال، وهنا يواجه الأردن معضلة مزدوجة، فمن جهة، انهيار السلطة قد يعني انفجار فراغ أمني يفتح الباب أمام موجات تهجير، ومن جهة أخرى، بقاء سلطة ضعيفة ومفرغة من مضمونها يجعلها عبئًا سياسيًا على مستقبل حل الدولتين وعلى استقرار الإقليم برمته.
رابعًا: الجبهة الداخلية بين الحاجة للتحصين ومخاطر التآكل
لا يقلّ الداخل الأردني خطورة عن التحديات الخارجية؛ فالجبهة الداخلية هي خط الدفاع الأول في مواجهة سيناريوهات الضم والتهجير، وقد أثبتت أحداث "طوفان الأقصى" أن البنية المجتمعية الأردنية ما تزال متماسكة، وأن العشائر والقوى الشعبية قادرة على التعبير عن وحدة وجدانية عابرة للتباينات، إلا أن هذه اللحظة التضامنية لا تعفي من مواجهة الحقائق الصعبة تتمثل في تراجع الثقة بالمؤسسات، وتفاقم التفاوتات الاجتماعية، وتنامي نزعات الانكفاء الفردي.
خامسًا: تنويع التحالفات ومشاغلة الخصم
في ظل انحياز البيت الأبيض غير المسبوق إلى أقصى اليمين الإسرائيلي، يصبح من الملحّ للأردن أن يعيد صياغة سياسته الخارجية على نحو أكثر تنوعًا ومرونة، صحيح أن الصين ليست خيارًا عمليًا مباشرًا، إلا أن التباين الآخذ في الاتساع بين المواقف الأوروبية والأمريكية - خصوصًا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية - يمنح عمّان نافذة للمناورة الدبلوماسية، ومن هنا، فإن "المشاغلة القانونية والسياسية" عبر المحافل الدولية، بما في ذلك ملاحقة الانتهاكات الإسرائيلية أمام المحاكم والمنظمات الدولية، تمثل خيارًا ضروريًا لتقليل الخسائر وإبقاء القضية الفلسطينية حيّة على أجندة المجتمع الدولي.
سادسًا: العقيدة القتالية والجيل الجديد
يطرح البعد العسكري تحديًا مغايرًا يتصل بالتحولات القيمية داخل المجتمع الأردني، فبينما يشهد المجتمع الإسرائيلي صعود أجيال أكثر عنفًا وتطرفًا وتدينًا، فإن الجيل الأردني الشاب يعاني انقطاعًا متزايدًا عن الموروث القيمي التقليدي، وتراجعًا في الاستعداد للتضحية الجماعية، وهو ما يهدد، على المدى البعيد، بفقدان عنصر الردع الشعبي في مواجهة المخاطر الوجودية، ومن ثمّ، يصبح من الضروري إعادة تنشئة وطنية تعيد الاعتبار للعقيدة القتالية والانتماء الجماعي، وهو ما يفسر أهمية مبادرات إعادة الخدمة الوطنية كآلية لإعادة بناء الهوية الدفاعية المشتركة.
إن الأردن، وهو يقف في عين العاصفة، لا يملك ترف الانتظار أو الارتهان لوعود خارجية قد لا تتحقق، فالمعادلة تقتضي مشروعًا وطنيًا متماسكًا يقوم على ثلاثة أعمدة رئيسية: أولها تعزيز الاعتماد على الذات اقتصاديًا وسياسيًا، ثانيها تنويع التحالفات الخارجية دون التفريط بالثوابت الاستراتيجية، وثالثها تحصين الجبهة الداخلية على المستويات كافة، فدون هذه الركائز، سيظل الأردن عرضة لضغوط الضم الزاحف ومشاريع التهجير الناعم، في سياق إقليمي متحوّل يوشك أن يعيد رسم خرائط المنطقة وفق مقاييس القوى الكبرى، لا وفق إرادة شعوبها.
الفصل الثالث: التهديدات الاستراتيجية مقابل متطلبات الاستجابة
يكتسب هذا الفصل أهميته من كونه يتناول أحد أكثر المفاصل حساسية في النقاش الوطني حول الأمن القومي الأردني، وهو المفصل الذي يربط بين الرؤية البحثية وبين تحويل خلاصاتها إلى سياسات عامة قابلة للتنفيذ. فالمداولات الفكرية مهما بلغت من دقة وعمق، تفقد فاعليتها ما لم تُترجم إلى توصيات عملية تُدرج في دوائر صناعة القرار. والاكتفاء بإنتاج المعرفة دون نقلها إلى فضاء القرار يعمّق حالة من "الركود الاستراتيجي" التي تحوّل النقاش إلى مجرد تمرين ذهني منفصل عن متطلبات الحماية الوطنية. من هنا، فإن الحاجة إلى استنهاض الإرادة السياسية الأردنية تصبح مطلبًا ملحًا، ولا سيّما في لحظة إقليمية تتسم بتقلّبات جيوسياسية عميقة وموجات غير مسبوقة من إعادة تشكيل موازين القوى.
ويتجاوز الصراع الراهن حدوده الجغرافية ليكتسب أبعادًا هوياتية وميثولوجية، إذ يغتذي من سرديات دينية ـ تاريخية تُستحضر بوصفها مبرّرًا وجوديًا للصراع، وهو ما يضفي عليه طابعًا يتعالى على الحسابات السياسية التقليدية ويجعل آليات التفاوض أو التسوية المرحلية أقل قدرة على لجم دوافعه العميقة. هذه الطبيعة المركّبة تُفسر اتساع دائرة الاستهداف الإسرائيلي وامتدادها إلى بيئات متعددة في سوريا ولبنان والعراق واليمن، مع غياب شبه كامل لأي ردع عربي متماسك، الأمر الذي يكرّس عمليًا "أحادية اليد الطولى" في المشرق ويعيد تعريف مفهوم السيادة في المنطقة.
في هذا السياق، تبدو الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، من قرار ضم منطقة الأغوار إلى الشروع في بناء سياج إلكتروني بتمويل أميركي، وتشكيل وحدات عسكرية متخصصة لتأمين تلك المنطقة، بمثابة عملية إعادة ترسيم فعلية للحدود وتحدٍّ صريح للاتفاقيات الموقعة سابقًا. هذه الخطوات، التي تحمل في طياتها بعدًا استراتيجيًا يتجاوز مجرد السيطرة المكانية، تضع الامتداد الحدودي الأردني ـ الفلسطيني في صلب دائرة التهديد، وتطرح على الأردن تحديًا مباشرًا يتعلق بإعادة تعريف مقاربة أمن حدوده وعمق سيادته. وتتضاعف خطورة هذه المعطيات في ضوء المؤشرات المتواترة عن وجود إسرائيلي متنامٍ في الجنوب السوري، ولا سيّما في محافظتي درعا والسويداء، بما يقلّص زمن الإنذار المبكر ويجعل محور الشمال أكثر قابلية للاختراق مقارنة بالمحور الغربي الذي تقيّده تضاريس طبيعية معقدة.
ويفاقم هذه التحديات انكشاف البنية العربية أمام احتمالات الاستهداف، فغياب منظومة دفاع عربي مشترك فاعلة يعمّق فراغ القوة ويترك دول المشرق أمام واقع من التفكك الاستراتيجي، فيما يظل الخطاب السياسي والإعلامي العربي في كثير من الأحيان أسير بيانات تنديد إنشائية عاجزة عن بلورة رواية مضادة أو ممارسة ضغط دبلوماسي حقيقي.
وإذا كان من الممكن استشراف ثلاثة مسارات رئيسية لتطور التهديد، فإنّ أولها يتمثل في احتمال تصعيد عسكري قد لا يكون وشيكاً لكنه يظل قائمًا على المدى المتوسط والبعيد، ولا سيّما إذا استمرّ مسار الضم والتمدد الإسرائيلي، أما الثاني فيتجلى في إمكانية استخدام أدوات الضغط الاقتصادي والدبلوماسي عبر اتفاقيات الطاقة والغاز وسلاسل الإمداد بما يحوّل تلك الأدوات إلى رافعة ابتزاز سياسي، في حين يتمثل المسار الثالث في مشروع استنزاف طويل الأمد يُبقي الأردن وسائر دول الجوار في حالة انكماش استراتيجي دائم، ويمسّ تدريجياً باستقلالية القرار الوطني.
أمام هذه المعطيات، يصبح لزامًا على الدولة الأردنية أن تنتقل من موقع التلقي إلى موقع المبادرة عبر استراتيجية استباقية متعددة الأبعاد، ويقتضي ذلك، أولًا، تفعيل مخرجات الحوار الوطني ومراكز البحث في شكل خطط عمل تنفيذية واضحة الأفق، مقسّمة زمنيًا إلى إجراءات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، بحيث تغدو التوصيات البحثية أداة سياساتية مباشرة لا مجرّد وثائق معرفية.
كما يتطلّب الأمر إعادة تعريف منظومة الردع الوطني من خلال تطوير قدرات الدفاع الجوي والاستخبارات الاستباقية وتعزيز البنية السيبرانية، بما يرسّخ القدرة على الردع الذاتي دون الارتهان إلى ضمانات خارجية يصعب التعويل على ديمومتها. وفي موازاة ذلك، يستدعي المشهد إعادة تشكيل تحالفات إقليمية انتقائية مع قوى قادرة على موازنة النفوذ الإسرائيلي ـ الأميركي، كتركيا مثلًا، والانفتاح بحذر على أطر تعاون مع قوى دولية أخرى مثل الصين وروسيا، من غير الوقوع في فخ الارتهان أو استبدال تبعية بأخرى.
ويغدو تحصين القرار الوطني اقتصاديًا عنصرًا حاسمًا في هذه المعادلة، من خلال تنويع مصادر الطاقة والمياه وإعادة تقييم اتفاقيات الغاز والكهرباء، وإرساء بدائل استراتيجية تحمي الأردن من أي ابتزاز أو انقطاع قسري، غير أنّ هذه الاستجابة تبقى ناقصة ما لم ترافقها عملية تجديد للعقد الاجتماعي الداخلي تعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، بما يمنح صانع القرار شرعية واسعة تمكّنه من تبنّي سياسات أمن قومي أكثر جرأة، ويتكامل ذلك مع ضرورة تطوير خطاب سياسي وإعلامي رصين يتجاوز التنديد إلى صياغة سردية أردنية ـ عربية متماسكة، قادرة على استقطاب الدعم الإقليمي والدولي وتثبيت مرتكزات المصلحة الوطنية في السجال العالمي.
إنّ ما يواجه الأردن اليوم بيئة هيمنة مركّبة تسعى إلى إعادة صياغة توازن القوى في المشرق العربي على نحو يهمّش أدوار الفاعلين التقليديين، والمطلوب في مواجهة هذا المشهد المضطرب مقاربة شاملة تمزج بين الاستباق الأمني والتحصين الداخلي وصياغة تحالفات ذكية، بما يعيد للأردن زمام المبادرة ويحافظ على سيادته وهويته الاستراتيجية في إقليم يتجه بثبات نحو إعادة ترتيب معادلات القوة والمصالح.
الفصل الرابع: التحولات الإسرائيلية - الفلسطينية وانعكاساتها على معادلة الخيارات الأردنية
لقد كان اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في منتصف التسعينيات نقطة انعطاف فارقة؛ إذ مثّل لحظة "انقطاع تاريخي" أفضت إلى تقويض مسار التسوية الذي تهيأ بعد مؤتمر مدريد. ففي طور النشأة، بدت إسرائيل أقرب إلى مشروع تحكمه هيمنة التيار اليساري، إلا أنّ الدخول في عملية السلام أتاح للتيار اليميني المتشدد أن يتسلّل تدريجيًا إلى مركز السلطة، مستندًا إلى سرديات لاهوتية وأساطير "أرض الميعاد" الكامنة في الضفة الغربية، ولا سيّما في القدس والخليل ونابلس، لا في مدن الساحل المحتل عام 1948. ومن هنا برز اغتيال رابين بوصفه فعلًا تأسيسيًا يفتح الطريق أمام "نكوص" عن مشروع السلام، ويمنح القوى اليمينية ذريعة لإعادة إنتاج إسرائيل وفق تصورها التوراتي.
تكرّس هذا التحول لاحقًا مع انقسام الساحة الفلسطينية بين غزة والضفة الغربية، وهو انقسام لم يكن، في جوهره، مجرّد صدفة سياسية، وإنما أداة استراتيجية أسهمت، موضوعيًا، في إضعاف أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية ذات تمثيل جامع. وقد تقاطعت في تغذية هذا الانقسام اعتبارات إسرائيلية صريحة مع عوامل إقليمية متشابكة، ما جعل الانفصال بين الكيانين السياسيين بمثابة "مسمار حاسم" في نعش حلّ الدولتين. بالنسبة إلى الأردن، لم يكن هذا التطور إلا مساسًا مباشرًا بمصالحه الوجودية؛ إذ يشكّل قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 ضمانة لتوازن ديموغرافي وسياسي يحول دون انزلاق الصراع إلى تخوم الدولة الأردنية.
ومن ثمّ، جاء الموقف الأردني بعد السابع من أكتوبر على درجة غير مسبوقة من الحزم، حيث ارتفع منسوب الخطاب الرسمي – ممثلًا بجلالة الملك ووزير الخارجية – في رفض الحرب على غزة والسعي إلى كبح تداعياتها. وقد استند هذا الموقف إلى إدراك عميق بأن إضعاف المقاومة في غزة، وما يوازيه من محاولات لتفريغ السلطة الفلسطينية في الضفة، يفضيان إلى تهديد جوهري للأمن القومي الأردني. غير أنّ هذا التهديد لا يتخذ شكل غزو عسكري تقليدي؛ فإسرائيل، رغم تفوقها في سلاح الجو والصواريخ وامتلاكها قدرات نوعية على تنفيذ عمليات اغتيال دقيقة، أثبتت عجزها عن احتلال غزة احتلالًا مباشرًا وشاملًا، فكيف بها أن تعبر نهر الأردن أو تتمدد في سيناء أو لبنان أو سوريا؟... إنّ ما تمتلكه إسرائيل هو قدرة على شن ضربات موضعية تشريحية، لا مشروعاً لاجتياح واسع النطاق.
وعوضًا عن احتلالات تقليدية، كرّست الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما في ظل قيادة نتنياهو، مقاربة تقوم على "إخماد بؤر المقاومة" في الإقليم من خلال مزيج مركّب من التلويح بالقوة العسكرية واستخدام الضربات عن بعد، بدءًا من جنوب لبنان وحزب الله، مرورًا بالساحة السورية، وصولًا إلى الحوثيين في اليمن، وهي بذلك تسعى إلى تثبيت نمط من الهيمنة الاقتصادية والسياسية والأمنية يمهّد لقيام "إسرائيل كبرى" من خلال شبكة نفوذ متداخلة تتحكم بمفاصل القرار الإقليمي وتعيد صياغة موازين القوى دون الحاجة إلى سيطرة جغرافية مباشرة.
وعليه، يصبح من مقتضيات الضرورة الاستراتيجية – أردنيًا وعربيًا على السواء – الدفع باتجاه إعادة تأهيل السلطة الفلسطينية ودعمها إلى أقصى مدى، من خلال إعادة بلورة بنيتها المؤسسية وتشريعاتها الناظمة، وتوفير سبل تمكينها من استعادة دورها التمثيلي. كما يغدو من الملحّ، مهما بدت الظروف معاكسة، إيجاد صيغة لإعادة إدماج غزة في بنية السلطة، بحيث يُعاد بناء كيان سياسي فلسطيني أقرب إلى "شبه دولة" حتى وإن تعذّر قيام الدولة الكاملة في المدى القريب.
وتحمل القراءة الاستشرافية مؤشرًا على أن اليمين الإسرائيلي، وقد بلغ ذروة سطوته، قد يدخل خلال السنوات المقبلة في مسار انحدار تدريجي، ما قد يتيح فسحة سياسية جديدة شريطة أن تتهيأ البيئة الفلسطينية وتُستعاد قدرة السلطة على التعبير عن الإجماع الوطني.
إنّ التقاط مثل هذه اللحظة يتطلّب من الأردن الجمع بين صبر استراتيجي طويل النفس ومبادرة دبلوماسية مرنة، فضلًا عن بلورة موقف عربي متماسك يقي مشروع الدولة الفلسطينية من التلاشي، ويحصّن في الآن نفسه ركائز الأمن القومي الأردني ضمن مشهد إقليمي يموج بإعادة صياغة موازين القوة والنفوذ.
الخاتمة:
إنّ تفكيك معادلة الأمن الوطني الأردني في سياقها الراهن يفضي إلى استنتاج حاسم مفاده أنّ مصدر التهديد يتجسد في مشروع استراتيجي عابر للجغرافيا السياسية يسعى، عبر أدوات مباشرة وغير مباشرة، إلى إعادة صياغة الإقليم برمّته، بما يضع الأردن أمام معادلة بالغة الخطورة تتراوح بين احتمالات التفكيك وإعادة التوظيف ضمن منظومات إقليمية جديدة لا تراعي بالضرورة مصالحه الوطنية العليا.
وعليه، فإنّ الاستجابة الوطنية لا يجوز أن تُختزل في الارتهان للتحالفات الكلاسيكية أو في تبنّي مقاربة أمنية أحادية البعد، بقدر ما تتطلب هندسة شاملة لإطار أمني – سياسي – اقتصادي - إعلامي متداخل الأبعاد، يرتكز على تحصين الجبهة الداخلية، بالتوازي مع تنويع محاور الانفتاح الإقليمي والدولي، وتطوير أدوات مبتكرة قادرة على امتصاص الضغوط الخارجية وتوليد توازنات جديدة.
وفي ضوء ذلك، يغدو مستقبل الأردن رهنًا بقدرته على إعادة صياغة مفهوم مركّب للأمن الوطني، يقوم على المزاوجة بين الواقعية السياسية والمرونة الاستراتيجية، وعلى المواءمة بين مقتضيات التحديات الوجودية من جهة، ومتطلبات التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة من جهة أخرى؛ بحيث يتمكّن من حماية بنيته الداخلية من التآكل، وصون سيادته من الاختراق، وتثبيت مكانته كفاعل إقليمي يحافظ على استمرارية الدولة ويحول دون انزلاقها في مدارات الإضعاف الممنهج.
صادر عن مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير
14/9/2025