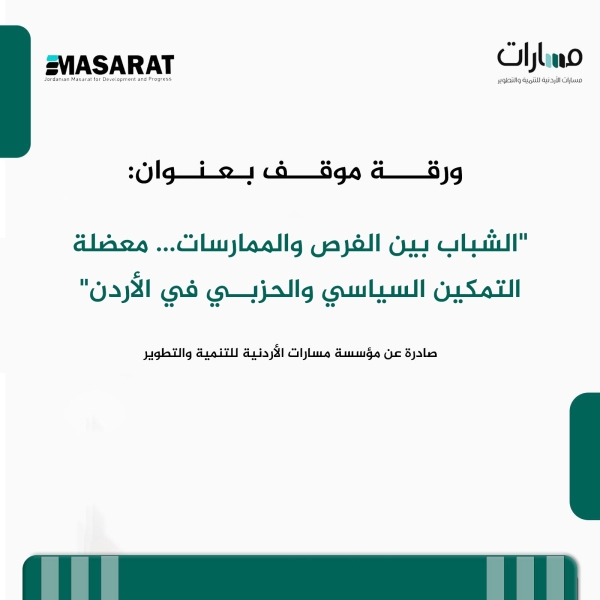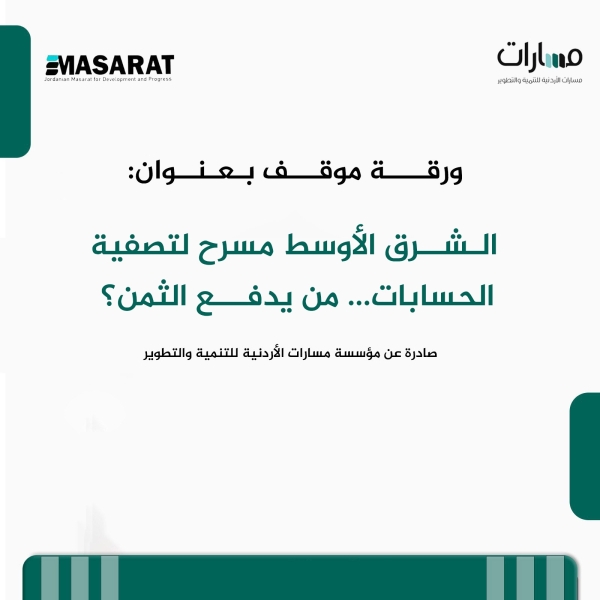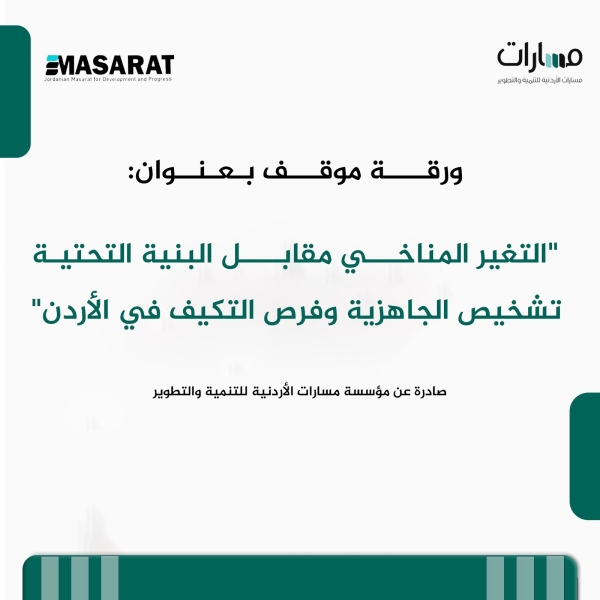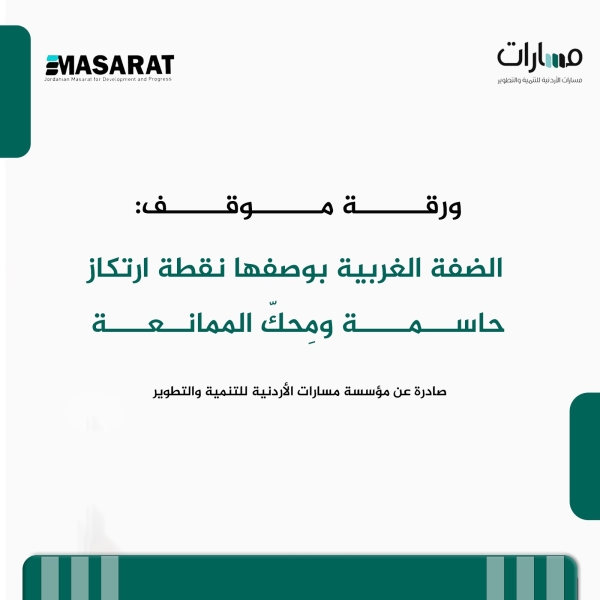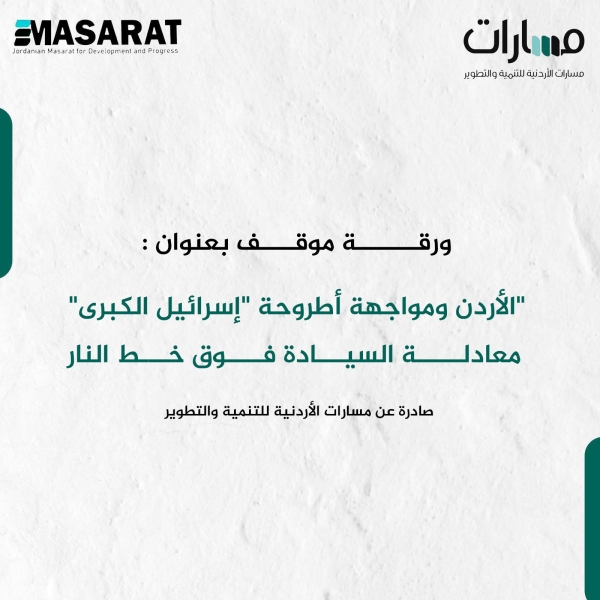ورقة الموقف: "الحياة الحزبية... إعادة ترتيب الأوراق واستعادة الثقة"
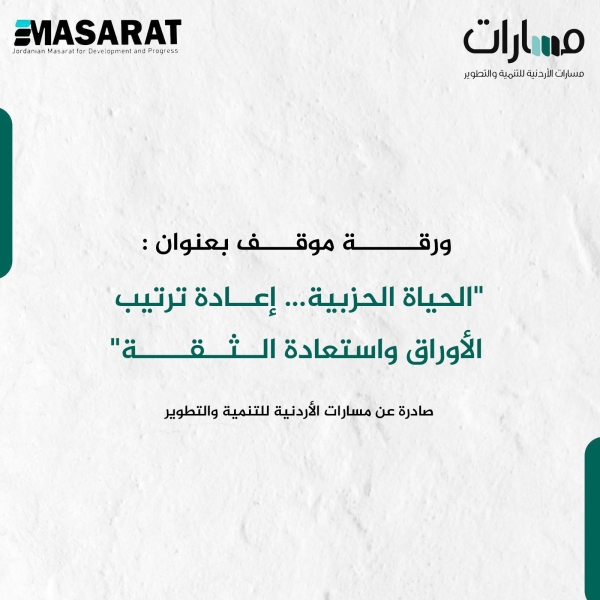
إليكم ورقة الموقف: "الحياة الحزبية... إعادة ترتيب الأوراق واستعادة الثقة"، والتي تتناول قدرة الأردن على مواجهة تعقيدات المرحلة الراهنة، والتي لا تنفصل عن منهجية شاملة تقوم على التوازي بين إعادة هيكلة الحياة الحزبية بما يضمن انتقالها من التعددية الشكلية إلى الجدية الفاعلة، وبين تعزيز صلابة المؤسسات الوطنية على المستويين السياسي والاقتصادي، فنجاح التجربة الحزبية في استعادة ثقة المواطنين هو شرط لازم لإطلاق عملية تحديث متكاملة تعيد الاعتبار للمشاركة الشعبية، وتحوّلها من ممارسة رمزية إلى رافعة عملية للاستقرار السياسي والتنمية المستدامة.
ورقة موقف بعنوان: "الحياة الحزبية... إعادة ترتيب الأوراق واستعادة الثقة"
صادرة عن مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير
المقدمة:
يجد الأردن نفسه أمام معادلة شديدة التعقيد، حيث تتقاطع الضغوط الداخلية مع التحديات الخارجية في لحظة انتقالية مفصلية، فمن جهة، تكشف التجربة الحزبية الممتدة منذ خمسينيات القرن الماضي عن عجز مزمن في الوصول إلى مستوى مؤسسي ناضج قادر على إنتاج برامج واقعية وخطابات إقناعية، الأمر الذي انعكس في اتساع فجوة الثقة بين الأحزاب والمجتمع، وفي تراجع المشاركة السياسية إلى مستويات مقلقة، ومن جهة أخرى، تفرض البيئة الإقليمية تحديات مضاعفة تتمثل في التصعيد الإسرائيلي المستمر، الذي يكرس مشروع "إسرائيل الكبرى" عبر سياسات التهجير والاستيطان، إضافة إلى التداعيات المستمرة للأزمة السورية وما تولّده من انعكاسات أمنية واقتصادية واجتماعية ضاغطة، فضلًا عن التنافس الإقليمي والدولي على إعادة تشكيل معادلات النفوذ في المنطقة.
أمام هذا الواقع المركّب، تصبح مهمة الدولة الأردنية مضاعفة، فمن الداخل، يتعيّن إعادة هيكلة المشهد الحزبي بما يعزز الجدية والفاعلية ويستعيد الثقة الشعبية، ومن الخارج، يتطلب الأمر تحصين السيادة الوطنية وإيجاد مقاربة متوازنة تحفظ المصالح الفلسطينية وتقي المملكة تداعيات الاصطفافات الإقليمية، ومن هنا، تغدو صياغة رؤية وطنية شاملة ضرورة وجودية، لا ترفًا سياسيًا، تقوم على ركائز مترابطة تتمثل في مؤسسات سياسية قوية وفاعلة، منظومة إعلامية واعية وقادرة على التأثير في السرديات، اقتصاد منتج ومستدام قادر على امتصاص الضغوط، ونظام تعليمي يؤسس لأجيال متسلحة بالفكر النقدي والمهارات الحديثة، إذ إن بلورة هذه الرؤية تمثل الشرط الحاسم لتمكين الأردن من تثبيت موقعه الإقليمي والدولي، والحفاظ على تماسكه الداخلي في مواجهة بيئة غير مستقرة بطبيعتها.
الفصل الأول: مأزق التجربة الحزبية في الأردن بين الرهانات المعلّقة وإكراهات الواقع
تُظهر التجربة الحزبية في الأردن، منذ إعادة العمل بالتعددية السياسية مطلع تسعينيات القرن الماضي، ملامح أزمة ممتدة ومتعددة الأبعاد، لا يمكن اختزالها في ضعف الأداء الانتخابي أو محدودية الحضور البرلماني للأحزاب فحسب، إذ إن جذورها تمتد إلى بنية الثقافة السياسية السائدة وآليات إنتاج النخب، فضلًا عن طبيعة التفاعل بين الدولة والمجتمع في المجال العام، ورغم تعاقب موجات الإصلاح ومحاولات التحديث، التي بلغت ذروتها مع إطلاق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فإن المأمول لم يتحقق بعد، إذ ما زال المشهد الحزبي يتسم بالهشاشة والعجز عن الترسخ كأداة وسيطة فاعلة بين المجتمع ومؤسسات الحكم.
إن التشخيص الدقيق لهذا المأزق يكشف عن مفارقة جوهرية: فالإطار التشريعي الذي ينظم الحياة الحزبية يتسم بالمرونة والانفتاح، حيث يكفل الدستور والقوانين ذات الصلة حرية التنظيم السياسي ويؤسس لتعددية حزبية، غير أن الممارسات العملية قد أفرغت هذه النصوص من مضمونها، فالأحزاب في معظمها بُنيت على قاعدة الكمّ لا الكيف، واستندت في التأسيس إلى حشد العضويات أكثر مما استندت إلى توافق فكري أو انسجام برامجي، وبهذا تحوّلت العديد من الكيانات الحزبية إلى هياكل شكلية تفتقر إلى العمق الأيديولوجي، ما جعلها عاجزة عن بلورة مشاريع سياسية أو اقتصادية متكاملة قادرة على استقطاب قواعد اجتماعية واسعة أو التأثير في القرار العام.
يُضاف إلى ذلك أنّ إعادة تدوير النخب التقليدية داخل العمل الحزبي أضعف ثقة الشارع بالعملية برمتها، حيث جرى استخدام الأحزاب أداة للعودة إلى مواقع النفوذ السياسي، بدل أن تكون فضاءً لإنتاج قيادات جديدة أو تعبيرًا عن ديناميات المجتمع المتغيرة، وهذه الظاهرة أسهمت في ترسيخ انطباع مجتمعي سلبي مفاده أنّ العمل الحزبي ليس سوى امتداد لآليات المحاصصة، الأمر الذي أفقده الشرعية الشعبية الضرورية لنجاح أي مشروع سياسي إصلاحي.
وعلى مستوى الممارسة، برزت كذلك إشكالية الفردنة والمصلحية في إدارة بعض الأحزاب، حيث تم تغليب الحسابات الشخصية على مقتضيات العمل الجماعي، بما يفرغ العملية الحزبية من محتواها التشاركي، ويجعلها أقرب إلى تحالفات مؤقتة تتبدل وفق المصلحة الآنية، بدلًا من أن تكون مؤسسات راسخة تخضع لبرامج طويلة الأمد، وهذا الخلل انعكس مباشرة في ضعف البرامج الانتخابية، وغياب القدرة على تقديم بدائل سياساتية واقعية، فضلًا عن الفشل في التمدد الجغرافي نحو الأطراف والمحافظات التي تشكّل الخزان المجتمعي الأوسع.
ولا يمكن فصل هذه التحديات الداخلية عن المحددات الإقليمية والدولية التي تفرض نفسها على الأردن، فالدولة الأردنية تتحرك في محيط إقليمي مضطرب، يتسم بإعادة تشكّل الخرائط الجيوسياسية، وبتصاعد المشاريع التوسعية الإسرائيلية، لا سيما أطروحة "إسرائيل الكبرى" التي تعيد إنتاج سياسات الضمّ والإقصاء على نحو أكثر وضوحًا وعلانية. وفي ظل هذا السياق، يغدو غياب أحزاب أردنية قوية وفاعلة بمثابة ثغرة معقدة، إذ يحرم الدولة من أداة حيوية في بلورة خطاب وطني جامع، يواكب التحديات ويعزّز الموقف التفاوضي والسيادي للأردن في مواجهة الأطروحات الخارجية.
وبناءً على ذلك، فإن مأزق التجربة الحزبية يجمع بين إشكاليات الثقافة السياسية المحلية، وقيود الممارسات العملية، وانعكاسات البيئة الإقليمية، كما أن تجاوزه يتطلب إعادة بناء شاملة للحقل الحزبي، تقوم على تأسيس ثقافة سياسية جديدة تُعلي من شأن العمل الجماعي، وتعزز المشاركة الشبابية والنسوية، وتواكب التحولات الرقمية والإعلامية، بما يجعل الأحزاب قادرة على أداء دورها الطبيعي كحاضنة للنقاش العمومي، وكسند مؤسسي للاستقرار السياسي والسيادة الوطنية في آن واحد.
الفصل الثاني: تحديات التجربة الحزبية بين متطلبات الشرعية الدستورية وأزمة الثقة المجتمعية
إن التجربة الحزبية في الأردن تقف اليوم أمام مفترق طرق بالغ الحساسية، فهي من جهةٍ تستند إلى مناخ غير مسبوق من الحريات السياسية والانفتاح النسبي في العملية الانتخابية خلال المرحلة السابقة، بما وفر بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة لانخراط الأحزاب في الفضاء العام على نحو أوسع، غير أنّ هذه المكتسبات، على أهميتها، لم تُترجم بعد إلى بناء تجربة حزبية ناضجة قادرة على صياغة خطاب سياسي مؤسَّس، أو إنتاج برامج واقعية تستجيب لأولويات الشارع الأردني.
فالمشهد الحزبي الراهن ما يزال، في كثير من جوانبه، يعاني من مظاهر الارتجال والعشوائية سواء في إدارة البنى الداخلية للأحزاب أو في صياغة خطابها السياسي، حيث جرى في بعض الحالات الدفع بوجوه لا تحظى بقدر كافٍ من الاحترام والقبول المجتمعي، ما أدى إلى تراجع صورة الأحزاب في الوعي العام، وعزز الشكوك حول قدرتها على تمثيل المصالح الوطنية بجدية. ويكاد هذا المشهد يشكّل، في أحد أبعاده، استنساخًا باهتًا لتجربة التسعينات، من حيث محدودية الفاعلية وتغليب الكم على النوع، دون أن يقترن ذلك بتطوير فكري أو تنظيمي حقيقي.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فإنّ المرحلة السابقة قد أفرزت وقائع لا يمكن تجاهلها، إذ إنّ نتائج بعض الأحزاب في الانتخابات الأخيرة تجاوزت حجم قاعدتها الشعبية المفترضة، وهو ما يعكس مستوىً من الانفتاح في العملية الديمقراطية لم يكن معهودًا سابقًا. ومن هنا، يصبح من الواجب البناء على الإيجابيات وتعزيزها، مع الاعتراف في الوقت ذاته بضرورة النقد الموضوعي للممارسات السلبية.
غير أنّ الإشكالية الأعمق تكمن في إطار الشرعية الدستورية، حيث يظل سقف الدستور المرجعية العليا التي لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها، سواء من قبل الأحزاب أو من قبل أي جسم سياسي أو نقابي، إن احترام النصوص الدستورية والالتزام بأحكامها متطلب جوهري لاستدامة العمل الحزبي وضمان تطوره. ولعلّ التجربة مع بعض النقابات المهنية، التي حاولت في لحظة ما تقديم نفسها كجسم موازٍ لسلطة الدولة، تقدم مثالًا صارخًا على أن أي محاولة لتجاوز المرجعية الدستورية ستؤدي بالضرورة إلى الانغلاق وربما الانهيار.
وبالموازاة مع ذلك، فإنّ القضاء يشكّل خطًا أحمر في منظومة العمل الوطني، باعتباره أحد الأعمدة التي يرتكز عليها مبدأ الفصل بين السلطات. ومن ثمّ، فإن التشكيك في أحكامه أو الانتقاص من مكانته لا يفضي إلا إلى إفراغ التجربة الديمقراطية من مضمونها، وإضعاف ركائز الدولة القانونية.
وعليه، فإنّ تطوير الحياة الحزبية يتطلب مراجعة جذرية على مستويين متوازيين:
- الأول داخلي، يتمثل في إعادة النظر في البنى التنظيمية للأحزاب، وتجديد برامجها السياسية، وطرح شخصيات تحظى بالاحترام الشعبي والقدرة على التعبير عن أولويات المجتمع.
- والثاني دستوري-مؤسسي، يتمثل في الالتزام الصارم بسقف الدستور وأحكامه، بما يحول دون تحوّل العمل الحزبي إلى مسار تصادمي مع الدولة أو إلى أداة لإعادة إنتاج مصالح ضيقة.
إن نضج التجربة الحزبية لن يتحقق إلا من خلال ترسيخ ثقافة المساواة أمام القانون، وتقديم خطاب وطني جامع، والانفتاح على القواعد الشعبية ببرامج واقعية تعكس التطلعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطن الأردني، وبدون هذه المراجعة الشاملة، ستظل الأحزاب عاجزة عن التحول إلى رافعة حقيقية للتحديث السياسي، ومجرد كيانات شكلية تفتقر إلى الثقة المجتمعية وإلى الفاعلية الوطنية.
الفصل الثالث: التمويل الحزبي بين معضلة الاستقلالية وإشكاليات الاستدامة
يشكّل موضوع التمويل أحد أبرز التحديات التي تواجه التجربة الحزبية الأردنية، إذ لا يمكن الحديث عن بناء حياة سياسية راسخة أو عن تحديث حزبي فاعل دون معالجة جذرية لمسألة الموارد المالية التي تؤطر عمل الأحزاب وتحدد نطاق حركتها، فالتمويل لا يقتصر على كونه عاملًا إداريًا أو تنظيميًا، فهو يتجاوز ذلك ليغدو معيارًا حاسمًا في اختبار جدّية المشروع الحزبي وقدرته على الاستمرار والتأثير.
لقد أظهرت التجربة العملية أن ضعف التمويل أو غياب آليات شفافة ومستدامة لتوفيره كان من بين الأسباب الجوهرية التي أدت إلى تعثر الكثير من الأحزاب بعد الاستحقاقات الانتخابية. فغياب الوحدة الداخلية على مستوى التنظيم، إلى جانب ضعف شبكات الدعم المالي، خلق حالة من التراجع الذي أفقد العديد من الأحزاب قدرتها على تجسيد برامجها أو ترجمة خطاباتها السياسية إلى فعل ملموس على الأرض. وفي هذا السياق، يُلحظ أن المشهد الحزبي لا يزال يراوح مكانه بين محاولات فردية في التمويل الذاتي، غالبًا ما ترتبط بالأشخاص النافذين داخل الحزب، وبين سعي محدود لتبني نماذج تشاركية قائمة على المساهمات الجماعية، وهي في معظم الأحيان لا تتجاوز البعد الرمزي ولا تؤسس لقاعدة مالية راسخة.
إن استبعاد خيار التمويل الخارجي، وإن كان مبررًا من زاوية السيادة الوطنية وحماية القرار السياسي من التدخلات الأجنبية، يفرض في المقابل مسؤولية مضاعفة على الدولة في ابتكار أدوات بديلة، فالمعادلة تبدو واضحة: إذا كان المطلوب من الأحزاب أن تشكل رافعة أساسية للتحديث السياسي، فإن تمكينها المالي يصبح شرطًا ملازمًا لذلك، ومن هنا يبرز الحديث عن ربط الدعم المقدم للأحزاب بمشاريع اقتصادية إنتاجية، بحيث يُصار إلى تمويل مبادرات ذات طابع تنموي قادرة على خلق فرص عمل للشباب، وتوليد موارد ذاتية تغني الحزب تدريجيًا عن الاعتماد الكامل على خزينة الدولة، على أن يُقرن هذا الدعم بمعايير صارمة للمساءلة والشفافية، تقوم على قاعدة "التمويل مقابل الإنجاز"، بحيث يُحرم الحزب الذي يفشل في إدارة موارده أو يتعثر في تنفيذ مشاريعه من الاستمرار في تلقي المخصصات العامة.
وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إن ربط التحديث السياسي بالتحديث الاقتصادي أضحى ضرورة عملية، فالأحزاب التي لا تملك قدرة مالية مستقلة ولا أدوات اقتصادية مستدامة ستظل عاجزة عن استقطاب الكفاءات أو تقديم برامج واقعية، ما يضعف مكانتها في المجتمع ويجعلها مجرد واجهات شكلية لا أكثر، أما الأحزاب التي تنجح في بناء قاعدة تمويلية متوازنة، فهي وحدها المؤهلة لأن تتحول إلى مؤسسات سياسية ذات حضور فاعل، قادرة على لعب دورها في إعادة تشكيل المشهد الديمقراطي وصناعة القرار الوطني ضمن إطار من السيادة والاستقلالية.
الفصل الرابع: معضلة البيئة السياسية واشتراطات الحريات في تفعيل الحياة الحزبية
إن التجربة الحزبية في الأردن، كما يؤكد العديد من الفاعلين السياسيين، لا يمكن أن تُقرأ بمعزل عن طبيعة البيئة السياسية التي تعمل ضمنها. فالحياة الحزبية انعكاس مباشر لمستوى الحريات العامة، والفصل بين السلطات، وحياد مؤسسات الدولة. ومن هنا، فإن غياب الضمانات الأساسية لتكافؤ الفرص، وبقاء السلطتين التشريعية والقضائية مرتهنتين - بدرجة أو بأخرى - لتأثير السلطة التنفيذية، يشكّل أحد أبرز مظاهر الخلل البنيوي الذي يعيق مسار الإصلاح السياسي، ويحول دون بناء حياة حزبية راسخة.
ولعل أبرز ما يفاقم هذه الأزمة هو هشاشة منظومة الحقوق والحريات العامة؛ إذ لا يمكن تصور حياة حزبية فاعلة دون فضاء حر يسمح للمواطنين بالتعبير والمشاركة والانخراط. غير أن الواقع يشير إلى تآكل الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة المختلفة، نتيجة التدخل المباشر في عمل مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك النقابات والجمعيات، التي كانت تُعد في السابق منصات شبه مستقلة للتعبير والممارسة الديمقراطية. بل إن الانتخابات النقابية، التي طالما شكّلت نموذجًا للشفافية، باتت تُدار بذات الأدوات التوجيهية، مما عمّق أزمة الثقة ورسّخ شعورًا بالاغتراب السياسي لدى قطاعات واسعة من المواطنين.
إن منظومة التحديث السياسي، التي جرى إطلاقها بوصفها مشروعًا وطنيًا طموحًا، لن تحقق أهدافها ما لم تُرافقها بيئة حقيقية للحريات، تسمح ببناء الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع. فالمواطن الأردني لا يمكن أن ينخرط في مشروع حزبي أو يلتف حول برامج إصلاحية، ما لم يلمس على أرض الواقع أن هذه البرامج تُترجم إلى أفعال، بعيدًا عن منطق الإقصاء وإعادة إنتاج الأزمات القديمة بأسماء جديدة.
وفي هذا السياق، يُطرح سؤال جوهري: كيف يمكن للأحزاب أن تُترجم برامجها إلى سياسات عملية دون وجود أدوات تنفيذية حقيقية؟ فالخبرة السابقة تشير إلى أن العديد من الأحزاب قد وضعت استراتيجيات شاملة، شملت معالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، غير أن تلك التصورات ظلّت حبيسة الأدراج، ولم تجد طريقها إلى التطبيق بسبب غياب الإرادة السياسية، وهيمنة الحسابات الضيقة على القرار التنفيذي.
وعليه، فإن التحدي الأكبر أمام الأردن في هذه المرحلة يتمثل في القدرة على خلق بيئة سياسية عادلة، تتجاوز منطق "التحكم عن بُعد" في المؤسسات، وتعتمد بدلًا من ذلك على مبادئ التشاركية، والالتزام بالدستور، والانفتاح الإعلامي المتكافئ على جميع الأطياف الحزبية. فبدون هذا التحول، سيبقى المشروع الإصلاحي مجرد عنوان طموح يفتقر إلى أدوات الإنجاز.
إن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية - بما فيها التصريحات المتطرفة الصادرة عن قادة الاحتلال حول ما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى" - تستلزم بناء جبهة وطنية داخلية متماسكة، عمادها أحزاب قوية، ومجتمع مدني حر، ومؤسسات رسمية قادرة على استعادة ثقة المواطن، فالمعركة مع الاحتلال تخاض أيضًا في ميدان السياسة الداخلية، حيث يشكّل بناء حياة حزبية حقيقية الضمانة الأولى لحماية السيادة الوطنية وصون الاستقرار في مواجهة رياح العاصفة الإقليمية.
الفصل الخامس: موقع العمل الحزبي في البنية الدستورية الأردنية
يحتل العمل الحزبي في التجربة السياسية الأردنية موقعًا إشكاليًا ومركّبًا، إذ يتقاطع مع جوهر البنية الدستورية من خلال الركن النيابي الذي يشكّل أحد الأعمدة المؤسسة للنظام السياسي. ومن هنا فإن إدراج الحياة الحزبية في قلب معادلة التحديث السياسي هو في حقيقته محاولة لإعادة صيلغة العلاقة بين المجتمع والدولة، بحيث تتشكل أغلبية حزبية في البرلمان قادرة، بموجب الدستور، على التدرج نحو تشكيل حكومات برلمانية حزبية. إن هذا التحول يحمل في طياته دلالات عميقة: فهو يؤشر من جهة إلى إدراك الدولة أن استمرار الديمقراطية الشكلية لم يعد كافيًا، كما يعكس من جهة أخرى رهانات معقدة على قدرة البيئة السياسية الأردنية على استيعاب هذا المسار وتحصينه من الانتكاس.
غير أن قراءة الواقع تكشف أن التجربة الحزبية ما تزال متعثرة، وأن الأحزاب لم تنجح، حتى اللحظة، في الارتقاء إلى مستوى الدور الدستوري الذي أُنيط بها نظريًا. فالعوائق التي تحول دون تحولها إلى قوى مجتمعية فاعلة تتوزع بين ثلاثة مستويات متداخلة:
أولًا، المستوى الداخلي، حيث يواجه العمل الحزبي بيئة سياسية مضيقة لم تتوفر فيها الشروط الكافية للنمو الطبيعي للحياة الحزبية. فالقيود الموضوعية على الحريات العامة، وضعف آليات المشاركة، وتراكم الممارسات البيروقراطية التي تعاملت مع الحزب باعتباره "مصدرًا للريبة" لا "معبراً عن الإرادة الشعبية"، كلها عوامل حدّت من حيوية الأحزاب.
ثانيًا، مستوى النخب السياسية، الذي يشكّل معضلة قائمة بحد ذاتها. إذ فشلت النخب في الالتزام بالانضباط الحزبي، وظلت أسيرة حساباتها الفردية، ما جعل الأحزاب كيانات هشة لا تتجاوز حدود الأشخاص الذين أسسوها. إن ثقافة تغليب الرأي الفردي على رأي المجموع الحزبي حالت دون تشكل كتل صلبة قادرة على تقديم حلول واقعية لمشكلات الدولة، بل أبقت الأحزاب في موقع التشرذم والتنافس الهامشي.
ثالثًا، المستوى الخارجي والإقليمي، حيث لم تكن التجربة الديمقراطية الأردنية في معزل عن ضغوط البيئة المحيطة، ذلك أن مرحلة الانفتاح الديمقراطي عام 1989 تعرضت منذ بداياتها لضغوط دولية وإقليمية مكثفة دفعت الأردن إلى الانكفاء ابتداءً من عام 1993، ما يعكس هشاشة التجربة حين تُواجه بمصالح القوى الكبرى ومعادلات التوازن الإقليمي.
وفي موازاة هذه المستويات، يظل العامل الشعبي مؤشرًا بالغ الأهمية على عمق الفجوة القائمة. فالبيانات الرسمية تؤكد أن أعداد المنتسبين للأحزاب لم يتجاوز 85 ألفًا من أصل أكثر من خمسة ملايين مواطن مؤهل، وهو رقم يعكس بوضوح أن الأحزاب لم تنجح في إقناع المجتمع بأنها أدوات حقيقية للتغيير، كما أن استمرار "رهاب الانتساب" لدى المواطن الأردني، رغم التعديلات القانونية التي جاءت في عام 2022 لتوفير ضمانات الانضمام، يرتبط بذاكرة سلبية راسخة من جهة، وبأولويات اقتصادية ضاغطة من جهة أخرى. فالمواطن، المثقل بأعباء البطالة وغلاء المعيشة، ينظر إلى العمل الحزبي باعتباره ترفًا سياسيًا لا يشبع احتياجاته المعيشية، بقدر ما يستهلك وقته وطاقته دون عائد ملموس.
وعلى صعيد البنية الداخلية للأحزاب ذاتها، تكشف المعطيات عن أزمات عميقة. فالأحزاب تعاني من تفكك تنظيمي ومن غياب البرامج المقنعة القادرة على تقديم حلول عملية لقضايا ملحّة كالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. كما أن ضعف أدواتها الإعلامية والتسويقية جعلها عاجزة عن مخاطبة الرأي العام، وهو ما عزز الانطباع الشعبي بأنها مجرد واجهات شكلية لا تتجاوز النخب السياسية الضيقة. والأسوأ أن معظم هذه الأحزاب ظلت مشدودة إلى شخصيات بعينها، ما منعها من التحول إلى تيارات فكرية مؤسسية قادرة على الاستمرار بمعزل عن الأفراد.
إن تجاوز هذه المعضلات يستدعي مقاربة متعددة الأبعاد تقوم على ركائز أساسية:
- أولًا، الإرادة السياسية العليا: إذ لا يمكن للعمل الحزبي أن يتقدم من تلقاء نفسه في ظل بيئة مثقلة بالموروثات السلبية، فهو يحتاج إلى دعم ورعاية صريحة من الدولة، تترجم عمليًا لا شكليًا، من خلال سياسات تشجع على المشاركة وتضمن استقلالية الأحزاب.
- ثانيًا، التحول من الأحزاب الفردية إلى التيارات الجامعة: وهو شرط لا غنى عنه لتشكيل كتل برلمانية قادرة على حمل مشروع وطني يتجاوز الانقسامات الجزئية.
- ثالثًا، إعادة بناء الثقة الشعبية: وذلك عبر برامج حزبية واقعية لا تكتفي بالشعارات، وإنما تطرح حلولًا تفصيلية لقضايا الفقر والبطالة والتعليم والصحة، ما يعيد الاعتبار للعمل الحزبي كأداة لتحسين الحياة اليومية للمواطن.
- رابعًا، استكمال المسار الديمقراطي: عبر معالجة ما وصفه بعض التقارير الدولية بواقع "الديمقراطية العرجاء"، وتجاوز القصور الذي يجعل الديمقراطية الأردنية ديمقراطية منقوصة في المضمون رغم وجود الهياكل الشكلية.
إن الأردن يقف عند مفترق بالغ الحساسية، فإما أن تتظافر جهود الدولة والنخب والأحزاب والمجتمع لإنجاح هذه التجربة الحزبية والتحول بها إلى رافعة للعمل البرلماني والحكومي، وإما أن ينزلق المشهد مرة أخرى إلى دائرة الانكفاء. وفي الحالة الأخيرة، سيكون الثمن باهظًا، ليس فقط بتأجيل الإصلاح لعقود جديدة، وإنما أيضًا بتكريس حالة فقدان الثقة بين المواطن والدولة، وإضاعة فرصة تاريخية لإرساء ديمقراطية مكتملة الأركان تستجيب لمتطلبات الداخل وتحصّن الأردن أمام ضغوط الخارج.
الفصل السادس: إعادة ترتيب الأوراق واستعادة الثقة
إعادة ترتيب الأوراق واستعادة الثقة ليستا مسألتين شكليتين أو إجراءً تنظيميًا بحتًا، وإنما تمثلان ضرورة تتصل بصلب الحياة الحزبية وموقعها داخل البنية السياسية الأردنية، فالمسألة لا تنحصر في تقديم طرف على آخر أو منح الأفضلية لقوة على حساب أخرى، وإنما تتعلق بإعادة صياغة المشهد العام على نحو يعيد ضبط الإيقاع السياسي ويمنح العملية الحزبية إطارًا أكثر صرامة ووضوحًا.
غير أن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه هو: متى امتلكت الأحزاب الأردنية ثقة شعبية حقيقية يمكن الحديث عن استعادتها اليوم؟... إن القراءة التاريخية تكشف أن أزمة الثقة حالة ممتدة نتجت عن تراكُم تشريعي وتنظيمي لم ينجح في تكريس قاعدة حزبية راسخة. ومن هنا يتضح أن عملية الاستعادة تتطلب أولًا اعترافًا صريحًا بأن الثقة لم تُبنَ أصلًا على مرتكزات صلبة، ومن ثم الشروع في معالجة مواطن الخلل بصورة جذرية.
القانون الصادر عام 2022 جاء استجابة لمسار طويل سبق تأسيس الدولة الأردنية وتطور عبر محطات متعددة. غير أن هذا القانون ارتبط بصورة مباشرة بالعملية الانتخابية، ما أفضى إلى حالة من "الفزعة الحزبية"، حيث اندفع كثيرون إلى تأسيس كيانات سياسية غايتها الأساسية المشاركة في الانتخابات النيابية، أكثر مما هي تعبير عن مشروع فكري أو رؤية تنظيمية مستدامة. وهكذا أصبحت قيمة الحزب تُقاس بقدرته على الوصول إلى البرلمان، بدلًا من أن تُقاس بمدى فاعليته الفكرية والتنظيمية وقدرته على إنتاج خطاب مقنع وحشد جماهيري حقيقي.
في الديمقراطيات الراسخة، تُستمد أهمية الحزب من وجوده ذاته كإطار سياسي ـ اجتماعي يُبلور الأفكار ويخوض معركة تشكيل الرأي العام، بصرف النظر عن حجمه البرلماني في لحظة زمنية معينة. أما في التجربة الأردنية، فقد أدى اختزال الحزب في وظيفته الانتخابية إلى فراغ واسع على مستوى العمل المجتمعي والقدرة على بناء الثقة الشعبية.
إن استعادة التوازن تستلزم إعادة الاعتبار لدور الأحزاب بوصفها أدوات للتنشئة السياسية، ومؤسسات تحمل مشاريع اقتصادية واجتماعية وفكرية تتجاوز اللحظة الانتخابية. ويتطلب ذلك إعادة هيكلة العلاقة بين الأحزاب ومجلس النواب، بحيث لا يكون البرلمان غاية في ذاته، وإنما محطة ضمن مسار سياسي أوسع يُمكّن الأحزاب من ترسيخ حضورها على المستويين الوطني والمحلي.
كما أن معالجة أزمة الثقة لا يمكن أن تنفصل عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن الأردني، من فقر وبطالة وغياب ملموس لنتائج ملموسة في حياته اليومية. فالإحباط الشعبي من الأداء السياسي عمومًا، ومن الأحزاب والبرلمان خصوصًا، يفاقم حالة العزوف ويضعف أي محاولة للتجديد. ومن هنا يصبح الرهان الحقيقي على قدرة الأحزاب في إعادة وصل خطابها بواقع الناس، والانطلاق من احتياجاتهم المباشرة كمدخل لاستعادة الشرعية الشعبية.
الفصل السابع: تقليص عدد الأحزاب وتعزيز الجدية لاستعادة الثقة
تكشف نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة أنّ ثقة المواطنين بالأحزاب السياسية لا تتجاوز سقف 30–35%، في وقت يتجاوز فيه عدد الأحزاب المرخّصة 36 حزبًا، وهذا التباين الصارخ بين الكمّ الحزبي والفاعلية المجتمعية يعكس فجوةً هيكلية بين الشارع السياسي من جهة، وبين قدرة الأحزاب على إنتاج خطاب إقناعي أو برامج واقعية من جهة أخرى.
إن التضخم الحزبي خارج حدود الحاجة الطبيعية للطيف السياسي الأردني أفرز حالة من الضعف المؤسسي والارتباك الشعبي، حيث يجد المواطن، بل وحتى النخب السياسية، صعوبة في المقارنة بين هذا العدد الكبير من الأحزاب أو التمييز بين إضافاتها النوعية. النتيجة الطبيعية لذلك هي تآكل الاهتمام الشعبي وتراجع المشاركة السياسية، بالمقابل، فإن تقليص عدد الأحزاب عبر اندماجات استراتيجية مدروسة يمثّل مدخلًا جوهريًا لإعادة الاعتبار للجدية الحزبية، إذ يتيح للمواطن خيارات أوضح، ويمنح الأحزاب قاعدة أوسع وفرصة أكبر للتأثير في المجال العام.
غير أنّ نجاح هذه العملية مشروط بتوافر معالم فكرية وبرامجية واضحة داخل كل حزب، بما يسمح له بتقييم نقاط الالتقاء والاختلاف مع الآخرين، فغياب الهوية الفكرية الواضحة أو البرامج الواقعية يحوّل الاندماجات إلى مجرد عمليات شكلية غير قادرة على إنتاج قوة حزبية مؤثرة. من هنا، تصبح عملية إعادة هيكلة المشهد الحزبي بمثابة خطوة تأسيسية لتعميق الجدية، واستعادة ثقة المواطنين، وترسيخ قواعد اجتماعية حقيقية قادرة على ترجمة البرامج إلى حضور ملموس في الحياة العامة.
إن تقليص عدد الأحزاب قد يكون خيارًا استراتيجيًا يهدف إلى بناء تحالفات مؤسسية قوية، وكسر حلقة الإحباط الشعبي المتراكمة، وتعزيز الاستقرار السياسي، على أن تترافق هذه العملية مع مراجعة شاملة للبرامج والأطر الفكرية، بحيث يقوم الاندماج على أسس واضحة، ويغطّي الطيف السياسي من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، دون إفراغ أي طرف من مضامينه الجوهرية.
بهذا المعنى، يغدو الإصلاح الحزبي انتقالًا من مرحلة الكمّ والشكل إلى مرحلة الجوهر والمضمون، وهو ما يعيد الاعتبار لدور الأحزاب كفاعل ديمقراطي رئيسي، ويمنح المشاركة السياسية وزنًا ومعنىً حقيقيًا في نظر المواطن الأردني.
الفصل الثامن: نحو اندماج حزبي وبناء تجربة جديدة تعترف بأخطاء الماضي
في خضم المرحلة الانتقالية التي يمر بها الأردن، تتبدى الحاجة الماسة إلى مراجعة جذرية للتجربة الحزبية السابقة، التي وإن شهدت منذ خمسينيات القرن الماضي محاولات متكررة، فإنها لم تفضِ إلى بناء تنظيمات حزبية مؤسسية راسخة، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي الذي استطاع الحفاظ على حضور تنظيمي نسبي، وبذلك بقي المشهد الحزبي الأردني هشًّا، قائمًا على محاولات متفرقة غير مكتملة البناء، ما أفرز حالة من التشتت السياسي وأضعف ثقة المواطنين بالأحزاب.
التجربة الماضية، بكل ما حملته من إخفاقات وإخفاقات جزئية، شكلت - على الرغم من ذلك -ضرورة تاريخية لا يمكن تجاوزها؛ إذ كشفت عن مواطن الخلل وأبرزت دروسًا ثمينة، فقد تبيّن بوضوح أن العمل الحزبي الجاد يتطلب بنى تنظيمية متماسكة، وديمقراطية داخلية حقيقية، وآليات شفافة للحَوْكمة، إلى جانب قدرة على بلورة برامج واقعية وفكر واضح، وإقناع المواطن الأردني بأن الحزب إطار شامل للعمل التطوعي والتمويل الذاتي والمبادرات المجتمعية.
اليوم، يقف المشهد الحزبي أمام مرحلة اندماج جديدة، حيث تشهد الساحة تحركات لإعادة التموضع وإعادة التنظيم من أجل بناء كيانات أكثر قوة وفاعلية، وهذا المسار يقوم أيضًا على الاعتراف بأخطاء الماضي ومعالجتها، والانطلاق برؤية أكثر نضجًا وقدرة على التأثير، فالاندماجات الجارية، تمثل محاولة لإعادة صياغة التجربة على نحو إيجابي، يفتح الباب أمام بناء ثقة مجتمعية متجددة.
غير أن هذه الخطوات لا تخلو من تحديات عميقة؛ يأتي في مقدمتها التمويل الحزبي، الذي يشكل العائق الأكبر أمام استدامة العمل المؤسسي، فالثقافة المجتمعية السائدة لا تزال تنظر إلى التبرع للأحزاب باعتباره وسيلة للوصول إلى المناصب، لا باعتباره مساهمة وطنية لبناء منظومة حزبية فاعلة ومستقبل سياسي أكثر استقرارًا. كما أن هناك حاجة ماسة إلى مراجعة تشريعية، وعلى رأسها تعديل قانون الانتخاب بما يمنح الأحزاب سلطة أكبر على ممثليها في القوائم المحلية، ويضمن انسجام العمل البرلماني مع التوجهات الحزبية.
إلى جانب ذلك، ثمة ضرورة لتوسيع مساحة النقد والحوار السياسي، بما يتيح للأحزاب تطوير خطابها وتغذية رؤيتها بالآراء المتنوعة، ويبقى الشرط الأهم هو ترسيخ الإيمان الحقيقي بالعمل الحزبي لدى الفاعلين السياسيين والجمهور معًا، باعتباره الخيار الديمقراطي الأكثر قدرة على إنتاج قيادات مؤهلة وبرامج وطنية جامعة.
إن الاندماج الحزبي، إذا ما جرى على أسس واضحة، لا يمثل مجرد إعادة ترتيب شكلي للمشهد، بقدر ما يمثل خطوة استراتيجية لإعادة بناء الحياة الحزبية الأردنية على أسس أكثر صلابة، بما يعزز المشاركة السياسية، ويمنح المواطن شعورًا حقيقيًا بأن صوته يمكن أن يصنع فارقًا في المستقبل.
الخاتمة:
قدرة الأردن على مواجهة تعقيدات المرحلة الراهنة لا تنفصل عن منهجية شاملة تقوم على التوازي بين إعادة هيكلة الحياة الحزبية بما يضمن انتقالها من التعددية الشكلية إلى الجدية الفاعلة، وبين تعزيز صلابة المؤسسات الوطنية على المستويين السياسي والاقتصادي، فنجاح التجربة الحزبية في استعادة ثقة المواطنين هو شرط لازم لإطلاق عملية تحديث متكاملة تعيد الاعتبار للمشاركة الشعبية، وتحوّلها من ممارسة رمزية إلى رافعة عملية للاستقرار السياسي والتنمية المستدامة.
وفي موازاة ذلك، فإن التحديات الإقليمية المتسارعة تفرض على الأردن أن يوازن بين الحفاظ على استقلالية قراره الوطني وصون سيادته، وبين التفاعل المرن مع ضغوط المحيط الدولي والإقليمي، بما يحمي مصالحه العليا ويعزز مكانته كفاعل وسطي متزن في بيئة مضطربة. ومن هنا، فإن تحويل التحديات إلى فرص يتطلب إرادة سياسية واضحة، ومراجعات تشريعية وتنظيمية معمّقة، ورؤية استراتيجية طويلة الأمد تراعي اعتبارات الأمن القومي والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية معًا.
إن الأردن، بما يمتلكه من إرث مؤسسي راسخ، وقاعدة سياسية، واقتصادية، واجتماعية تطمح إلى الإصلاح، يقف اليوم أمام فرصة تاريخية لتثبيت نموذج وطني قادر على الجمع بين الاستقرار والانفتاح، وبين الهوية الجامعة والمواطنة الفاعلة، ومن شأن هذا النموذج أن يضع المملكة في موقع أكثر صلابة في وجه المتغيرات، وأكثر قدرة على بناء مستقبل يعكس إرادة شعبها وتطلعاته، بعيدًا عن الإحباطات المرحلية والارتباكات الظرفية.
صادرة عن مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير
8/9/2025