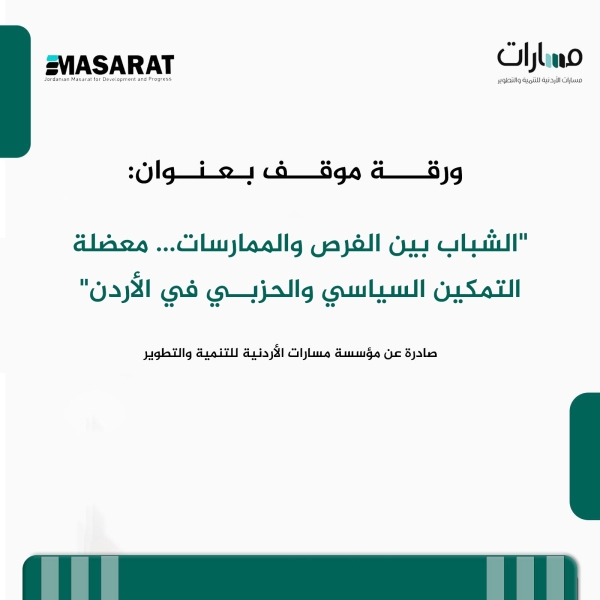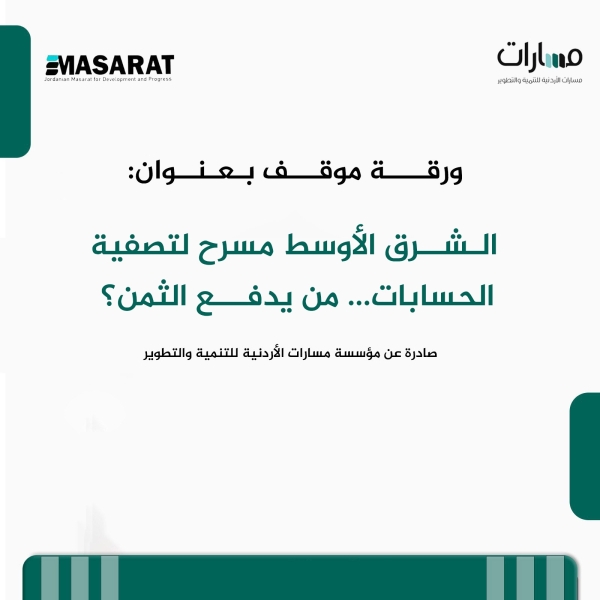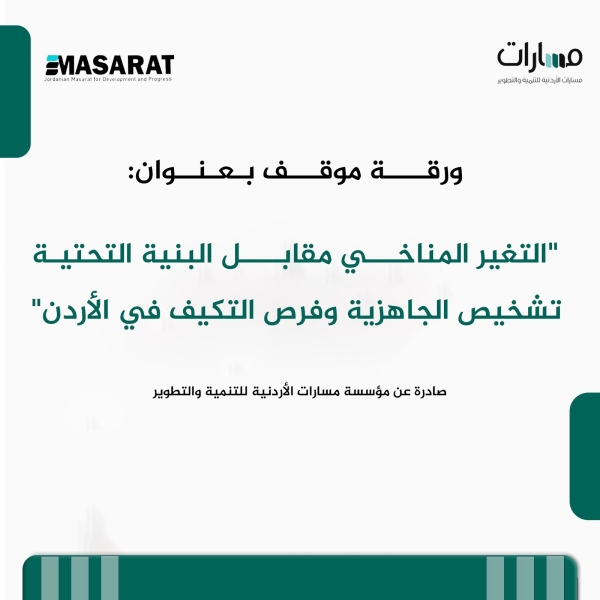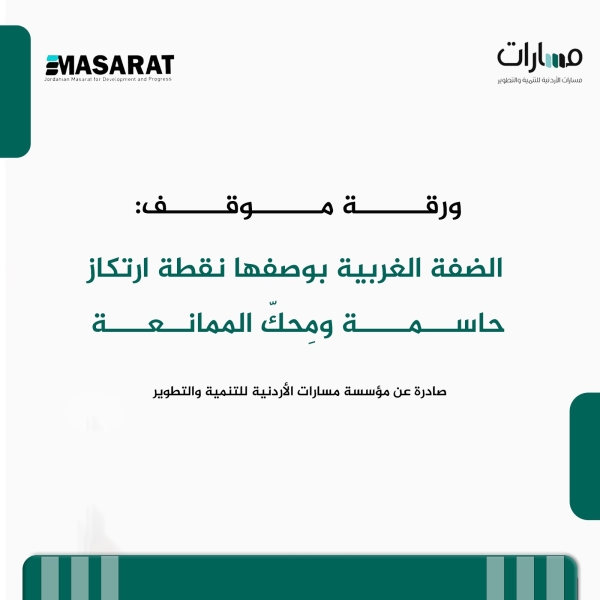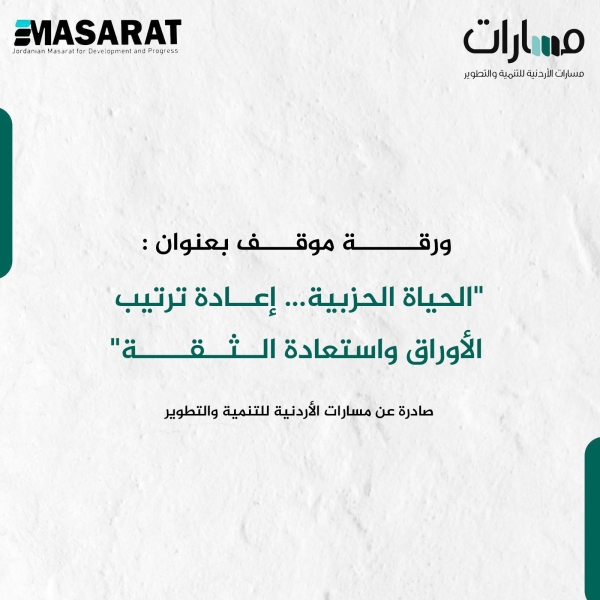ورقة الموقف بعنوان: "ارتدادات الصراع: التداعيات الاقتصادية للحرب الإسرائيلية الإيرانية على الأردن"
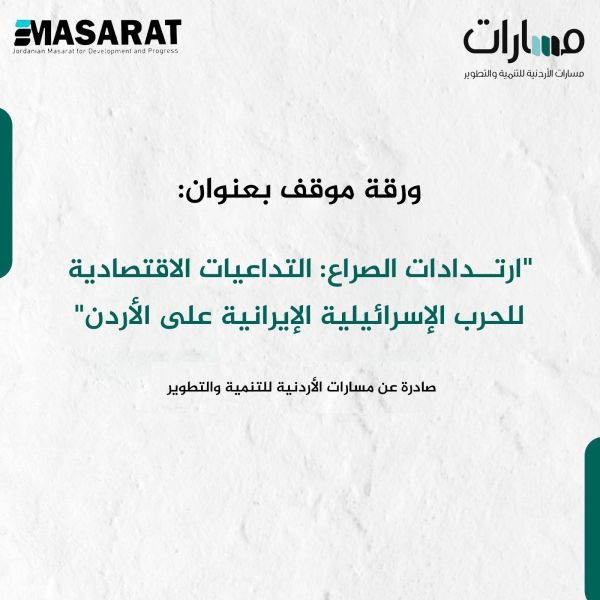
مقدمة:
تتنامى في الأفق ملامح مرحلة انتقالية تعيد ترتيب قواعد الانخراط في الأسواق، وإعادة تعريف مفهومي "النفاذ التجاري" و"السيادة الاقتصادية"، وتضع اقتصادات الدول الصغيرة والمفتوحة – كالأردن – أمام مفترق طرق يتجاوز مجرد التأثر اللحظي بالأزمات. فالحرب الإسرائيلية الإيرانية، بما أفرزته من اضطرابات في سلاسل الإمداد وممرات الطاقة والملاحة الإقليمية، كشفت عن أزمة طارئة، في البنية الاقتصادية الأردنية، وعن غياب رؤية شمولية للتحصين الاقتصادي القائم على أدوات الاقتصاد الكلي لا على استجابات قطاعية مجتزأة.
ولا يمكن في هذا السياق إغفال الارتباط بين تداعيات هذه الحرب وسياسات الانكفاء القومي الاقتصادي التي باتت سِمة مميزة للعالم بعد 2016، حين دشّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة تجارية حمائية صارمة، أرست معادلة جديدة في العلاقات التجارية الدولية، قائمة على فرض رسوم جمركية انتقائية، وإعادة التفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة، واعتبار الأمن القومي ذريعة للتضييق على بعض القطاعات والمنتجات، وقد كانت لهذه السياسة انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على الأردن، رغم ما توفره اتفاقية التجارة الحرة الثنائية من امتيازات تصديرية، إذ باتت تنافسية الأردن في السوق الأمريكية مهددة ضمن بيئة متقلبة تستبعد الامتيازات لصالح نزعة تفضيل الإنتاج المحلي الأمريكي، لا سيما في القطاعات التي تمثل ما يزيد عن 50% من الصادرات الأردنية كالألبسة والمنتجات الكيماوية.
وتكشف الورقة عن ارتدادات مركبة طالت مختلف مفاصل الاقتصاد الأردني، من تراجع حجم الطلب في قطاع السياحة، واضطراب التدفقات اللوجستية في واردات الغذاء، إلى هشاشة أمن الطاقة واعتماد الصناعة على مدخلات إنتاج مستوردة عبر ممرات مهددة كهرمز وباب المندب. وتنعكس هذه الارتدادات مباشرة على مؤشرات الاقتصاد الكلي، إذ تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة في الحفاظ على استقرار ميزان المدفوعات، وكبح التضخم المستورد، وتحقيق معدلات نمو تتجاوز سقف 2.5%، في ظل بطالة مزمنة تتجاوز 22%، ودين عام يُقدّر بنحو 114% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقيّد قدرتها على تنفيذ سياسات مالية توسعية، أو تحفيز الطلب الداخلي عبر الأدوات التقليدية.
وعليه، فإن الورقة تعيد تموضع النقاش ضمن الإطار السيادي للاقتصاد الكلي، من خلال طرح سؤال مركزي: كيف يمكن بناء "جاهزية اقتصادية كلية" قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية دون أن تفرغ الاحتياطات النقدية، أو تُهدد الاستقرار المالي، أو تقوض الثقة الاستثمارية؟.
هذا ما تسعى الورقة إلى معالجته، عبر تفكيك الارتدادات وربطها بخارطة التوازنات الاقتصادية الكبرى، للخروج بمجموعة من التوصيات التي تُمكّن الأردن من الانتقال من وضعية "اقتصاد يتعايش مع الأزمة" إلى حالة "اقتصاد يصوغ استراتيجيات استباقية ضمن الأزمة".
الفصل الأول: البنية الهشة للقطاع السياحي الأردني في سياق اضطرابات الإقليم وتغييب الاستراتيجيات المستدامة
أفرزت الحرب بين إسرائيل وإيران جملةً من التداعيات المباشرة وغير المباشرة على القطاع السياحي الأردني، كأحد القطاعات الاقتصادية الأكثر التصاقًا بالمشهد الإقليمي الجيوسياسي، فالسياحة، بطبيعتها، تعاني من حساسية مفرطة تجاه عوامل الاضطراب الإقليمي، وهو ما يجعلها أول المتأثرين بانفجار الأزمات، وآخر المتعافين منها.
وفي حالة الأردن، كشفت ارتدادات الحرب عن مجموعة من الاختلالات المتجذرة، لعل أبرزها هشاشة الهيكل التسويقي للسياحة الأردنية في مواجهة الأزمات المفاجئة، وغياب منظومة احتواء متماسكة قادرة على تحصين صورة المملكة كوجهة آمنة ومنفصلة نسبيًا عن دوامات الإقليم، إذ إن الموجة الواسعة من إلغاءات الرحلات التي رُصدت منذ اندلاع التصعيد، خصوصًا خلال فترات الذروة، تُعبّر عن عمق التأثر، وتؤشر على وجود فجوة إدراكية لم تُعالج بعد في وعي الأسواق الدولية.
ورغم تصنيف الأردن كواحدة من أكثر الدول استقرارًا وأمنًا في الشرق الأوسط، إلا أن هذا الامتياز لم يُترجم إلى بنية تسويقية استراتيجية تُعيد تموضع الأردن باعتباره "ملاذًا سياحيًا آمنًا ضمن إقليم مشتعل"، وإنما ظل الخطاب الترويجي تقليديًا، أقرب إلى رد الفعل منه إلى المبادرة، ما حال دون بناء سردية مضادة قادرة على عزل الأردن ذهنيًا عن محيطه المضطرب.
كما سلطت الحرب الضوء على محدودية قدرة السياحة الأردنية على التنويع الجغرافي في استهداف الأسواق، فمع أن الأسواق الغربية أكثر حساسية تجاه التوترات الإقليمية، إلا أن الاعتماد عليها لا يزال مرتفعًا، بينما لم تُفعّل بدائل نوعية، كالسوق الصينية أو بعض أسواق آسيا الوسطى، وهذه الإخفاقات ساهمت في تعظيم ارتدادات الحرب على القطاع، وعرقلت قدرة الأردن على الالتفاف حول تداعياتها.
من جهة أخرى، كشفت الأزمة عن غياب التكامل المؤسسي بين أدوات الاستجابة الوطنية، حيث لم تُسجّل تحركات نوعية على مستوى السفارات أو هيئة تنشيط السياحة لتقديم رسائل طمأنة منظمة، تعتمد على أدوات عصرية مثل الرحلات الاستطلاعية (FAM Trips)، واستثمار المؤثرين الرقميين، والتسويق المباشر القائم على نموذج "من شخص إلى شخص" (C2C)، فضلًا عن ضعف توظيف الذكاء الاصطناعي في تتبع توجهات السوق وإعادة توجيه الجهد الترويجي.
وتعمّقت الإشكالية في ظل عدم وجود استراتيجية احتواء إعلامي دبلوماسي تنأى بصورة الأردن عن الانطباعات الإقليمية، حيث غالبًا ما يتم إسقاط التوتر الإقليمي على الأردن بحكم الجوار، لا بفعل الوقائع، ما يؤكد غياب سردية بديلة تستثمر في عناصر القوة الوطنية كالأمن، الاستقرار، والموقع الجيواقتصادي الوسيط.
علاوة على ذلك، فإن التأثيرات الاقتصادية للصراع لم تقتصر على تراجع تدفقات السياح، وإنما امتدت إلى تعطيل بعض الاستثمارات القائمة أو المجدولة، وتجميد اتفاقيات محتملة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى استراتيجية حماية استثمارية تستبق الأزمات ولا تتعامل معها بمنطق الخسائر المحتومة.
وأخيرًا، تظل فجوة البيانات تحديًا هيكليًا أمام صانع القرار، إذ لا تزال المنهجيات المعتمدة في احتساب مساهمة السياحة غير دقيقة بما يكفي، بسبب تضمينها زيارات العبور أو الإقامة القصيرة، دون التمييز بين "السائح" و"الزائر"، ما يخلق فجوة إحصائية تُربك عملية التخطيط وتقييم الأثر الحقيقي للصراع على الناتج المحلي الإجمالي، الذي تُقدر مساهمة السياحة فيه بـ14–16%، لكنها تبقى رقمًا غير مكتمل دون إعادة تعريف المعايير وقياس الأثر النوعي لا العددي فقط.
وبناءً عليه، فإن التعامل مع الارتدادات السياحية للحرب الأخيرة، لا يتطلب إجراءات إسعافية ظرفية فقط، بقدر ما تتطلب إصلاحًا هيكليًا يبدأ بإعادة تعريف أدوات الترويج، وتوسيع دائرة الأسواق، وفصل الصورة الأمنية الوطنية عن اضطرابات الإقليم عبر خطاب دولي واضح وموحّد، يعيد تموضع الأردن في وعي السياح لا باعتباره دولة في جوار الخطر، وإنما كجزيرة أمان وسطه.
الفصل الثاني: الأمن الغذائي الأردني في مواجهة الأزمات المتشابكة... قراءة في جاهزية القطاع الخاص واستراتيجية إدارة الإمداد
أعادت الحرب بين إسرائيل وإيران طرح ملف الأمن الغذائي الأردني إلى الواجهة، وسط تصاعد المخاوف الشعبية من احتمالية اضطراب سلاسل التوريد، وظهور تساؤلات جوهرية حول مدى استعداد المملكة لمواجهة اختلالات فجائية في تدفق السلع الأساسية، في ظل بيئة إقليمية مشحونة، وتحديات لوجستية عابرة للحدود.
وقد دلّ السياق الطارئ الحالي على أهمية البنية التي راكمها القطاع الخاص على مدى العقود الأخيرة، باعتباره الفاعل المحوري في عمليات الاستيراد وتأمين السوق الوطني، خصوصًا منذ إعادة رسم أدوار الدولة والقطاع الخاص بعد أزمة "سلعة التونة" عام 1998، التي شكّلت نقطة تحول تاريخية في آليات إدارة المخزون الغذائي الأردني، وانتقال مسؤولية التوريد حتى في السلع الاستراتيجية – كالقمح – من الدولة إلى القطاع الخاص.
وخلال الأزمات المتعاقبة، أثبتت المنظومة الغذائية الأردنية قدرة تشغيلية لافتة على الصمود، بفضل استراتيجيات تعددية المصدر، والتوسع في شبكة الموردين، والانفتاح على أسواق جديدة، ما أتاح للمستهلك الأردني خيارات متنوعة، وقلّص من فرص تشكّل اختناقات حادة في التدفق السلعي، حتى في ذروة التوترات الجيوسياسية.
وفي مواجهة تداعيات الحرب الأخيرة، والتي تزامنت مع تهديدات فعلية للممرات البحرية الدولية، وأبرزها مضيق باب المندب الذي تمر عبره نحو 65% من الحاويات المتجهة إلى السوق الأردني، حافظت المنظومة الغذائية على استقرارها بفضل فتح مسارات بديلة، وتحرير البضائع العالقة في موانئ استراتيجية مثل جبل علي، وهو ما عكس جاهزية لوجستية فعّالة، وقدرة ديناميكية على تفكيك الأزمات المحتملة قبل تحوّلها إلى ارتدادات فعلية.
في المقابل، أبرزت الحرب أيضًا ثغرات في منظومة الحوكمة الإعلامية والمعرفية المرتبطة بالأمن الغذائي، حيث أظهرت التغطيات الإعلامية وتصريحات الجهات الرسمية تعدديةً غير منسّقة في مصادر المعلومة، ما ساهم في تضخيم حالة القلق الشعبي، وخلق انطباعات خاطئة حول وجود أزمة، رغم غياب أي مؤشرات واقعية على اختلال فعلي في توازن العرض والطلب.
وفي هذا السياق، بات من الضروري تأسيس مرجعية وطنية موحدة للمعلومة، تنشر البيانات بشكل آني ودقيق، وتعتمد خطابًا رقميًا شفافًا ومتماسكًا، بما يعزز الثقة العامة، ويمنع تشكّل بيئة نفسية هشة خلال الأزمات.
وتأسيسًا على ما سبق، فإن الأمن الغذائي الأردني، وإن كان قد أظهر صلابة واضحة في مواجهة تداعيات الحرب الأخيرة، إلا أن استمرار هذه الصلابة يستوجب تطوير إطار مؤسسي تكاملي أكثر نضجًا، يُفعّل التنسيق بين القطاعين العام والخاص، ويعيد إنتاج العلاقة بين الأداء الميداني والاتصال الجماهيري، بحيث لا يظل استقرار السوق رهين أداء القطاع الخاص وحده، وإنما مدعومًا ببنية حوكمة قادرة على إدارة التوقعات الشعبية وتحصين الجبهة الداخلية في اللحظات الحرجة.
الفصل الثالث: المجال الجوي الأردني... رئة استراتيجية في بيئة جغرافية خانقة
بات الربط الجوي للدول معيارًا نوعيًا لدرجة اندماجها في الاقتصاد العالمي، ومؤشرًا صامتًا على موقعها في شبكات التجارة، والسياحة، والتنقل البشري. وتُعدّ صناعة الطيران اليوم من أكثر القطاعات التصاقًا بالبنية الاقتصادية الكلية للعالم الحديث، إذ تستأثر بـ58% من حركة السياحة العالمية، وتوفّر أكثر من 86 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما تسهم بما يُقدَّر بنحو 4.1 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي جانب الشحن، تُنقل عبر الطيران ما يقارب 33% من القيمة الإجمالية للبضائع التجارية، لا سيما تلك ذات الخصائص الحساسة من حيث القيمة والوقت.
وبالنظر إلى السياق الأردني، تتكثّف أهمية المجال الجوي كممر سيادي حيوي نتيجة لطبيعة الموقع الجغرافي للمملكة، الذي، وإن اتسم بمزايا استراتيجية في الحسابات النظرية، إلا أنه مشروط ببيئة إقليمية متفجرة، تحدّ من فاعلية المنافذ البرية وتُقيّد الانفتاح البحري عبر شريط ضيق على خليج العقبة. وفي ظل هذه المحددات الجغرافية، يتكشّف المجال الجوي الأردني بوصفه "الرئة الوحيدة" التي تضمن استمرار تدفق الحركة التجارية والسياحية، وربط الأردن بالعالم، وهو ما يضفي على قطاع الطيران المدني بعدًا استراتيجيًا بالغ الحساسية.
وقد أظهرت أحداث الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، وتداعياتها على أمن الأجواء في المنطقة، كيف يمكن لأي اضطراب إقليمي أن يعيد رسم خريطة الملاحة الجوية خلال ساعات، وعلى الرغم من التحديات المتعددة، يشير الأداء الفعلي للقطاع إلى مرونة متقدمة، تمخضت عن تراكم الخبرات المستخلصة من جائحة كورونا، والأزمات اللوجستية المتكررة، إذ سُجّل نمو بنسبة 9% في أعداد المسافرين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، رغم استمرار التوترات في غزة والمنطقة.
وتعيد الأزمات المتكررة تسليط الضوء على غياب "نقل جوي وطني" فاعل، يمكن الركون إليه في حالات تعطّل شركات الطيران الأجنبية، وهي ثغرة تكشف عن الاعتماد الكلي على الفاعلين الخارجيين، وتجعل من مسألة "السيادة الجوية" ملفًا استراتيجيًا ينبغي تناوله بعقلانية، تراعي أهمية وجود مشغل وطني قادر على التدخل الفوري عند الحاجة، دون أن يتحول إلى عبء اقتصادي أو أداة احتكارية تخل بتوازن السوق.
إنّ إعادة التموضع الاستراتيجي لقطاع الطيران المدني الأردني في ظل بيئة إقليمية مضطربة، تتطلب رؤية تتجاوز البعد التشغيلي، نحو مقاربة أمنية واقتصادية وتكاملية، تجعل من السماء الأردنية موردًا سياديًا، قابلًا للتوظيف التنموي، ومرتكزًا للاستقرار الوطني، على غرار الأمن الغذائي وقطاع الطاقة.
إن حماية هذا المورد يستدعي بناء شراكات دولية مرنة، وتنويع خطوط الملاحة، وتطوير منظومات الإنذار المبكر والتنسيق المؤسسي، بما يضمن استدامة انفتاح الأردن الجوي على العالم، في ظل انغلاق بري وبحري يفرضه الجوار الجيوسياسي المضطرب.
الفصل الرابع: اختبار الصمود في زمن الأزمات المعقدة
يجد القطاع الصناعي الأردني نفسه أمام معضلة متجذّرة، تتجلى في ضعف روابطه التشغيلية مع الخارج، وارتباطه الحيوي بممرات عبور دولية باتت مرتهنة للحسابات العسكرية الإقليمية، فالارتدادات غير المباشرة للحرب بين إسرائيل وإيران، لا تقف عند حدود تهديد تدفق السلع، فهي تمس صميم السيادة الاقتصادية للدولة، وتعيد طرح تساؤلات جذرية حول النموذج الصناعي القائم، وأولويات الإصلاح المؤجل.
لقد أكدت سلسلة الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ووصولًا إلى العدوان الإسرائيلي المتكرر على غزة، ثم التوترات المتصاعدة في مضيقي هرمز وباب المندب، أن الاقتصاد الأردني – وعلى رأسه القطاع الصناعي – يعمل في بيئة دائمة التعرّض للاهتزاز. ويمكن تصنيف هذه الأزمات إلى نمطين متمايزين:
- أزمات معطّلة تفكك سلاسل الإمداد كليًا، كما في حالة الإغلاقات الشاملة خلال الجائحة.
- أزمات مقيّدة تُبقي على الشكل الظاهري للتجارة، لكنها تفخّخ خطوط التوريد بالمخاطر واللايقين، كما هو الحال حاليًا في التهديدات البحرية المتصاعدة.
في هذا السياق، أصبح مفهوم الاستدامة التشغيلية مرادفًا جديدًا للأمن الصناعي، خصوصًا في القطاعات الحيوية كالغذاء والدواء والطاقة. ورغم أن الصناعة الأردنية تُغطي ما نسبته 65% من احتياجات السوق في السلع الغذائية، و60% في الصناعات العلاجية، إلا أن اعتمادها الكبير على مدخلات إنتاج مستوردة يضعها في موقع مكشوف أمام الصدمات الدولية، ويقوّض قدرتها على التصرف الاستباقي في لحظات الأزمات.
التحليل المؤسسي يكشف عن إشكالية تتمثل في:
- قيود تنظيمية مزمنة تعرقل التصنيع المحلي للمدخلات، بسبب تضارب التعليمات، وتجزئة المرجعيات الإدارية، وغياب التنسيق بين الجهات المنظمة.
- تمييز ضمني في السياسات الاقتصادية يضع الصناعي المحلي في موقع تنافسي أدنى مقارنة بالمستورد، ما يُقلص الحوافز لتوطين الإنتاج.
- تأخّر إصلاح منظومة الطاقة، رغم وضوح الاعتماد المفرط على الوقود التقليدي في أكثر من 65% من القطاع الصناعي، وعدم استغلال الإمكانات الوطنية كمشروع حقل الريشة الغازي الذي يُفترض أن يُعامل كأولوية سيادية لا كمجرد استثمار تجاري.
أما على صعيد التصدير، فإن نحو 20% من الصادرات الأردنية تمر عبر مضائق بحرية باتت رهينة للتقلبات الأمنية، ما يكشف عن قصور استراتيجي في تنويع الأسواق والاعتماد المفرط على مسارات عالية الحساسية الجيوسياسية. وهو ما يستدعي صياغة جديدة للسياسات التجارية، قائمة على توسيع النطاق الجغرافي للشراكات، واستهداف أسواق بديلة أقل تأثرًا بالاصطفافات الإقليمية.
إن ارتدادات الحرب بين إسرائيل وإيران تمثل لحظة اختبار فاصلة، لا ينبغي أن تُقرأ من منظور الخطر الآني فقط، وإنما باعتبارها فرصة لصياغة تحول في فلسفة التصنيع الوطني. وهذا يقتضي تحركًا على ثلاثة مسارات مترابطة:
- تسريع الانتقال إلى طاقة أكثر أمنًا واستقرارًا.
- تحرير منظومة التصنيع من القيود التنظيمية والبنية البيروقراطية المتآكلة.
- بناء خريطة صادرات محصّنة جيوسياسيًا تتجاوز الاعتماد على الممرات البحرية عالية التهديد.
الفصل الخامس: قطاع الطاقة في الأردن بين استدامة البنية وارتدادات الإقليم
أجبرت التفجيرات المتكررة عام 2011 لخط الغاز المصري، الأردن على التحول إلى وقود ثقيل وديزل عالي الكلفة، الأمر الذي راكم عجزًا تجاوز 4 مليارات دينار خلال أربع سنوات. تلك الأزمة شكلت نقطة تحول محورية، تمخضت عنها سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية، أبرزها إنشاء ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة عام 2015، والذي ترافق تشغيله مع انخفاض أسعار النفط، ما ساهم في تقليص الكلف التشغيلية وتحقيق وفورات مالية مهمة.
ومع تعقّد المشهد الإقليمي بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، والحرب بين إسرائيل وإيران، عادت قضية أمن الطاقة إلى واجهة النقاش الاستراتيجي، خصوصًا مع التلويح المتكرر بإمكانية تعطيل مضائق الملاحة كهرمز وباب المندب، إذ يُقدّر أن نحو 65% من الحاويات والسلع المرتبطة بتدفق الطاقة تمر عبر هذه المضائق، ما يجعل الأردن عرضة مباشرة لأي انقطاع مفاجئ في الإمداد.
وفي محاولة لتقليص هذه التأثيرات، شهد القطاع تحولات في هيكل مزيج الطاقة، تمثلت في ارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 27% من الطلب المحلي، مقابل مساهمة متزايدة للصخر الزيتي (16%)، إلى جانب بناء تحالفات ربط كهربائي إقليمي، تتيح للبلاد هامشًا للمناورة في لحظات الطوارئ.
وفي الوقت ذاته، اتجهت الحكومة نحو تعزيز البنية التحتية التخزينية، من خلال مشروع الخزان البري للغاز في العقبة المتوقع تشغيله عام 2026، وهو ما سيُمكّن المملكة من تخزين الغاز لفترات استراتيجية، ويمنح صانع القرار الوطني مرونة أكبر في إدارة سيناريوهات الانقطاع أو الابتزاز الطاقي.
ومع ذلك، فإن تحديات المرحلة المقبلة تتجاوز مفاهيم التوليد والتوزيع، لتصل إلى ضرورة استكمال مشروعات التخزين، وتوسيع استثمارات الطاقة النظيفة، وتعزيز الاستقلال التشغيلي، ضمن رؤية طاقية متكاملة تُراعي المتغيرات الإقليمية، وتُحصّن المملكة أمام أي اضطرابات مستقبلية، سواء كانت أمنية، سياسية، أو اقتصادية.
الخاتمة
قد كشفت الحرب الإسرائيلية الإيرانية، بما تلاها من تصعيد إقليمي متداخل، عن بنية اقتصادية أردنية قائمة على نمط مزدوج، يظهر معه الغياب الكلّي لمقاربة وطنية شاملة لمفهوم "التحصين الاقتصادي"، وتستمر القطاعات في الأداء تحت ضغط الظروف لا استنادًا إلى خطط سيادية مضادة للهزات.
فعلى الرغم من القدرة الظرفية التي أبداها القطاع السياحي في امتصاص بعض ارتدادات الأزمات، إلا أنه لا يزال رهينًا لمنظومة تسويقية نمطية محدودة النطاق، تعجز عن اختراق الأسواق الدولية بوسائط متعددة أو أدوات رقمية تفاعلية، ما يُبقيه محكومًا برؤية تقليدية عاجزة عن مراكمة الزخم واستدامة الجذب، أما قطاع الطاقة، فرغم ما تحقق فيه من تطورات تقنية وبنية تحتية متقدمة، لا يزال معتمدًا على منظومة إمداد خارجية هشّة، تتسم بقابلية عالية للانقطاع عند كل منعطف جيوسياسي، الأمر الذي يجعل أمن الطاقة في الأردن مرهونًا بعوامل لا تقع ضمن نطاق السيطرة الوطنية الكاملة، في المقابل، تعاني الصناعة الوطنية – رغم ما تمتلكه من قدرة إنتاجية متنامية ومجالات توسع واعدة – من قيود تشريعية وتنظيمية متشابكة، جعلتها عالقة في منطقة انتقالية ضبابية، دون استراتيجية واضحة لتوطين مدخلات الإنتاج أو تحفيز التصنيع العميق القائم على القيمة المضافة.
وفي ظل هذه المفارقات الهيكلية، تضع الورقة جملة من الملاحظات الاستراتيجية التي ترقى إلى مرتبة "المهام الوطنية المؤجلة"، من أبرزها:
- ضرورة إحلال منظومة سيادية موحّدة للبيانات الاقتصادية، تُستقى منها جميع التصريحات الرسمية، وتستند إليها كل قرارات الاستجابة، بما ينهي فوضى الخطاب الاقتصادي المُجزأ.
- تسريع إعادة توطين الطاقة داخل الجغرافيا الأردنية من خلال تعظيم الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والتخزين الكهربائي، بحيث يصبح أمن الطاقة أحد أذرع السيادة الوطنية.
- تحديث المنظومة الصناعية بتوسيع نطاق التصنيع المحلي لمدخلات الإنتاج الاستراتيجية، وربط هذا المسار بحوافز ضريبية وتشريعية مدروسة، تُعيد هندسة التنافسية لصالح المنتج الوطني، دون افتعال قطيعة مع سلاسل الإمداد العالمية.
- إعادة تعريف مفهوم "التحوط الاقتصادي" بوصفه مركّبًا سياديًا يتطلب جهوزية أفقية بين مؤسسات الدولة، لا مجرّد استجابة قطاعية ظرفية تحت ضغط الحدث.
إن هذه الورقة، بما تضمنت من معطيات مباشرة من دوائر القرار والقطاع الخاص، تمثل مساهمة مبدئية باتجاه بلورة موقف وطني صلب، يحول الاقتصاد الأردني من اقتصاد يحتمل الأزمات إلى اقتصاد يواجهها ويصوغ شروطه ضمنها، لأن الجغرافيا السياسية لن تتغير، ولكن ممكنات إدارة أثرها يمكن – ويجب – أن تتغير.
صادرة عن مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير
29/6/2025